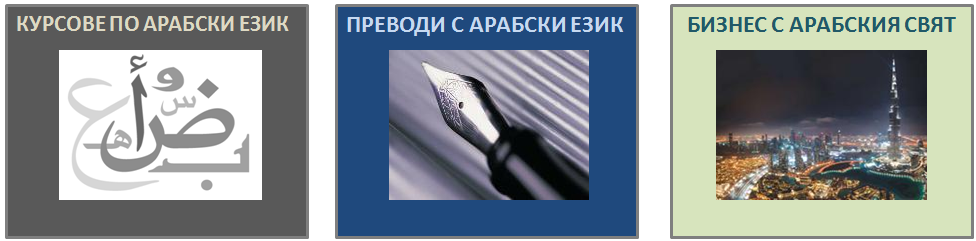المقدمة: النقاش حول المصطلح المناسب 1
2. نحو تعريف الحركة الإسلامية
أولا : الحركات الاجتماعية والسياسية كمدخل للدراسة
ثانيا : تعريفات الحركة الاجتماعية والسياسية
ثالثا : أسباب التطبيق وخصائص الحركات الاجتماعية والسياسية
رابعا : محددات نشاط الحركات الإسلامية
3. الحركات الإسلامية: النشأة والمدلول وملابسات الواقع
أولا : خلفية تاريخية – فكرية
ثانيا : النشأة
4. خريطة تصنيف الحركات الإسلامية
أولا : الحركات الإسلامية الدينية
ثانيا : الحركات الإسلامية – الاجتماعية ذات البرنامج الإسلامي
.
2. نحو تعريف الحركة الإسلامية
أولا : الحركات الاجتماعية والسياسية كمدخل للدراسة
ثانيا : تعريفات الحركة الاجتماعية والسياسية
ثالثا : أسباب التطبيق وخصائص الحركات الاجتماعية والسياسية
رابعا : محددات نشاط الحركات الإسلامية
3. الحركات الإسلامية: النشأة والمدلول وملابسات الواقع
أولا : خلفية تاريخية – فكرية
ثانيا : النشأة
4. خريطة تصنيف الحركات الإسلامية
أولا : الحركات الإسلامية الدينية
ثانيا : الحركات الإسلامية – الاجتماعية ذات البرنامج الإسلامي
.
المقدمة*
إن مجرد الحديث عن الحركات الإسلامية يلزم الباحث بمسلمات وافتراضات عدة، تبدأ من قبول الوصف الذاتي لهذه الحركات بأنها إسلامية، وتمر عبر رسم الحدود بين إسلامية هذه الحركات ولاإسلامية غيرها. فلا بد إذا قبل أن نشرع في تناول موضوع هذه الورقة من أن نتوقف قليلا عند المفاهيم والمصطلحات.[1] يطلق مصطلح "الحركات الإسلامية" (ويفضل بعض الباحثين مصطلح "الأصولية" ترجمة عن المصطلح الإنجليزي Fundamentalism، بينما يجنح آخرون إلى استخدام تعبير "الإسلاموية" ترجمة أيضا عن **Islamicist على الحركات التي تنشط على الساحة السياسية وتنادي بتطبيق قيم الإسلام وشرائعه في الحياة العامة والخاصة على حد سواء، وتناوئ في سبيل هذا المطلب الحكومات والحركات السياسية والاجتماعية الأخرى التي ترى أنها قصرت في امتثال تعاليم الإسلام أو خالفتها. ويغلب إطلاق هذا المصطلح على الحركات التي تصف نفسها بهذا الوصف وتنشط في مجال السياسة؛ إذ يندر مثلا إطلاق وصف الحركات الإسلامية على الجماعات الصوفية التي لا تنشط في مجال السياسة. ولا يطلق هذا الوصف عادة على الأحزاب التقليدية ذات الخلفية الإسلامية، مثل حزب الاستقلال في المغرب أو حزب الأمة في السودان، كما لا يطلق على النظم والحركات التي تحكم بالشريعة الإسلامية تقليديا كما هي الحال في المملكة العربية السعودية مثلا، بينما تطلق هذه الصفة على بعض حركات المعارضة لتلك الأنظمة. تعكس هذه الاستخدامات المسلمات النظرية الشائعة أو المستبطنة حول هذه الظاهرة، وطبيعة الفهم السائد إزاءها.
تبدو الحركاتُ الإسلامية إذ تميز نفسها عن التيار الشعبي العام، وتخصص هذا التمييز بنسبة نفسها إلى الإسلام، كما لو أنها تصدر حكما على المجتمع حولها بالتقصير عن الوفاء بقيم الإسلام، وتنصِّب نفسها قائما بمهمة التذكير والدعوة، وأحيانا الإكراه على تلافي هذا التقصير. وتتراوح ردود فعل القوى الأخرى تجاه هذه الدعاوى بين رفض مضمونها مع قبول أسسها (أي قبول التشخيص بأن المجتمعات لا تفي التدين حقه مع رفض دعوة الحركات الإسلامية في قيادة الصحوة لمرجوة) أو رفض الأسس والمضمون معا (القول إن المجتمعات هي إسلامية فعلا ولا تحتاج إلى من يذكرها بدينها)، أو قبولهما معا من منطلق مضاد تماما، شأن بعض المواقف العلمانية التي تقر بأن دور الدين في حياة المجتمعات تراجع كثيرا وأن الحركات الإسلامية تسعى إلى إحيائه، مع تأكيد أنها مهمة مستحيلة أو غير مرغوب فيها أصلا. ولا نريد في هذه المرحلة أن نحسم في أمر هذه الدعاوى أو الدعاوى المضادة، ولا أن نجزم بقول في مسألة التعريف حتى نستجلي بعض النقاط المتعلقة بالأساس النظري لهذا الحوار. ذلك أن كل حسم في هذه النقاط يستصحب موقفا نظريا أو قيميا معينا.
من الصعوبة الحديث بشكل تفصيلي وفي بحث واحد عن الحركات الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، إذ إن هذا الموضوع من الاتساع والتشعب بحيث لا يمكن إيفاؤه حقه إلا من خلال العديد من الأبحاث والدراسات.[2] لذا سأكتفي بتقديم عرض عام للحركة الإسلامية المعاصرة بشكل مختصر ومركّز حيث قد يبدو متجاوزا لبعض التفاصيل التي يعتقد البعض أنها في غاية الأهمية، وهذا ما لا أختلاف فيه مع أحد، ولكنني أحاول اختصار تجربة ما يقارب ثمانين عاما – منذ ظهور حركة الإخوان المسلمين، وعلى امتداد نحو عشرين دولة إسلامية – في بحث يهدف أساسا لكي يكون مدخلا عاما لفهم الحركة الإسلامية وما ينطوي عليه الموضوع من دوافع تأسيسها وتطويرها واتجاهات أيديولوجيتها.[3]
سأتناول في بداية الورقة تعريف عام للحركة الإسلامية بمثابتها حركة اجتماعية سياسية. ثم أتناول عرض أسباب قيامها الرئيسية وملامحها العامة، أنتقل بعد ذلك إلى تبسيط محددات نشاطها النموي. في الجزء الثاني من الورقة سوف أستعرض مقدمة موجزة عن نشأة الحركات الإسلامية المعاصرة وملابسات واقعها حيث أشير إلى عدة إشكالات في تصوير الغرب للخطر الكامن والقائم في الإسلام السياسي المرتبط باتسام بعض الحركات الإسلامية باستخدام القوة والعنف. ومن ثم ألتقي بعض الضوء على قضية رؤية الحركة الإسلامية للمفاهيم المتعلقة بالمشاركة السياسية. وأختتم هذه القراءة التشخيصية للحركات الإسلامية بتقديم خريطة انقسامها إلى حركات دينية وسياسية – اجتماعية ذات البرنامج الإسلامي.
إن الهدف الأساسي لهذا البحث هو تقديم عرض سريع وشامل لأهم المعلومات والاتجاهات المتعلقة بالحركات الإسلامية، وليست هذه كما ذكرنا بالمهمة اليسيرة وسط هذا الكم الهائل من الكتب والمقالات والجماعات والتطورات المتوالية. بأخذ ذلك في الاعتبار يكون الهدف من البحث في سياق هذه الدراسة متواضعا.
نحو تعريف الحركة الإسلامية
الحركات الاجتماعية والسياسية كمدخل للدراسة*
أجمع الكثير من علماء الاجتماع على أن الحركات الاجتماعية تعتبر بوجه عام ردود فعل لتغيرات بنائية في المجتمع، ومن ثم تكون مرتبطة بمتغيرات أخرى مثل التحولات في الاقنصاد والسكان والتكنولوجيا وبنية النظام السياسي ذاته؛ ويؤكدون أنه سواء تم النظر للحركات الاجتماعية على أنها عنصر هدم أو عنصر بناء في المجتمع، أو من زاوية المنهج الوظيفي أو منهج الصراع، فهي في جميع الحالات نتائج للاختلالات الاجتماعية داخل النظام.
وهذه الدراسة تركز على الحقائق الوصفية بما يقود إلى معرفة الأسباب والنتائج المترتبة على ظاهرة معينة حيث يتم التركيز على أربعة أبعاد:
أ) مسيرة الحركات الاجتماعية وتتضمن كيفية تطور ونمو هذه الحركات
ب) الصورة المؤسسية التي تأخذها
ج) الكيفية التي تصبح بها الحركات الاجتماعية جزءا من الحياة العامة للمجتمع، أي كيف تحظى بالمشروعية
د) الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الفترة الزمنية التي تظهر فيها الحركات ويتضمن ذلك أيضا العلاقة بين الحركات الاجتماعية والقوى السياسية الأخرى.
تعريفات الحركة الاجتماعية والسياسية**
طرح العديد من الباحثين تعريفات مختلفة للحركات الاجتماعية والسياسية، ولكن برغم اختلافها فإنها تجمع بين عدة عناصر رئيسية تميز هذه الحركات وسعى الباحثون إلى التفرقة بين الحركات وغيرها من المفاهيم مثل جماعات الضغط والمصالح والأحزاب والأهم من ذلك حرص بعضهم على تمييز الحركات الاجتماعية والسياسية عن غيرها من صور السلوك الجمعي. ففي المعنى الدقيق للحركات الاجتماعية والسياسية هي جهد جمعي ضعيف تنظيميا ولكنه يتسم بالإصرار على دعم هدف اجتماعي مؤداه إما تحقيق أو منع تغيير ما في بنية المجتمع ونظام القيم السائد.[4]ويعرفها هيربرت بلومر وهو أحد العلماء المهتمين بالسلوك الجمعي بأنها في التحليل الأخير تعد بمثابة سلوك جمعي يعبر عن عدم الكفاءة الاجتماعية أو القلق والاضطراب الاجتماعي في أثناء نموها، ومن ثم فإنها تتضمن كل مظاهر السلوك الجمعي.[5]ويعرفها د. رفعت سيد أحمد بأنها بمثابة جهد جماعي ومطلب مشترك بين جماعة من الناس يعملون معا، بوعي، وباستمرار على تغيير بعض أو كل أوجه النظام الاجتماعي والسياسي القائم، وأنهم يمرون بعدة مراحل لكي يصلوا إلى هذا الهدف، تبدأ عادة بحالة من القلق والتوتر الجماعي غير المنظم، لتنتهي بتكتيل صفوف ووعي القائمين بالحركة وتوجيههم نحو هدف واحد محدد وهو تغيير النظام الاجتماعي والسلطة السياسية القائمة.[6]
ويمكن استنتاج عدد من الركائز التي يستند إليها مفهوم الحركة الاجتماعية والسياسية وهي:
أ – حدوث مجموعة من الأفعال المتصلة والمستمرة لجماعة معينة من الناس.
ب – خلل اجتماعي في بناء القيم الثقافية والأوضاع الاجتماعية والنظام السياسي.
ج – توافر الوعي بعدم الرضا والسخط على الأوضاع القائمة، وبالأهداف المنشودة.
د – أن يستهدف هذا الجهد إحداث التغيير الاجتماعي.
ه – توافر الحد الأدنى من القدرة على إحداث التغيير، وذلك لأن السخط الذي يرجع إلى الفقر أو صراع القيم غير كاف وحده لتشكيل حركة وتوافر حد أدنى من التنظيم لتعبئة جهد الحركة وتحويله إلى نشاط ملموس.
وفيما يخص أسباب قيام الحركات الاجتماعية والسياسية فتشير الدراسات إلى أن هناك ثلاث مجموعات من العوامل تعد أسبابا لقيام الحركات، وقد تتوافر المجموعات الثلاث في قيام حركة ما أو تقتصر على نوع واحد منها وفقا لظروف كل حركة وهي كما يلي:
أ) العوامل النفسية والسيكولوجية: وتدور حول الأسباب التي تضعف ارتباط الشخص بجماعة تقليدية كالأسرة أو أي مؤسسة أخرى وتجعله يرغب في تحديها والمخاطرة بفقدان تأييدها ودعمها له لأنه أصبح يؤمن بقضية غير شائعة بين الناس، وتلك التي تشكل عناصر ترغيب له للارتباط بحركة ما.
ب) العوامل اجتماعية: ويقصد بها الشروط أو الظروف المحددة التي تؤدي فعلا إلى قيام الحركات الاجتماعية والسياسية، وليس الأسباب التي تشكل بوجه عام مناخا مواتيا لظهور الحركات. فمن الصحيح أن الأزمات الأقتصادية والسياسية، والفقر الواسع الانتشار والاختلالات الحادة في التركيب الطبقي للمجتمع تعد أسبابا قوية لحدوث حركات تطالب بالتغيير – ولكن من الممكن أن توجد جميع هذه الأسباب أو بعضها دون أن تنشأ الحركة فعلا، وذلك لأن هناك مجموعة من الشروط أو المتطلبات المنبثقة من هذه الأسباب الواجب توافرها، لأنها تمثل العوامل المباشرة أو المفجرة لقيام الحركة، ويمكن إجمالها في الآتي:
- اهتزاز القيم والمعايير، كأن تصبح القيم السائدة غير ملائمة للظروف الفعلية للحياة اجتماعية.
- القلق الاجتماعي، حيث يسبب انتشار بعض المشاعر مثل الشك واليأس حالة من القلق الاجتماعي، والذي يتولد نتيجة للاتصال بين الناس أو نتيجة الانتقال الاجتماعي السريع.
- الحرمان، والسخط والاحباط
- التحول في ميزان القوى داخل المجتمع. ويرجع ذلك إلى توزيع القوة يقف عائقا أمام أي فعل مؤثر من جانب أي جماعة تفكر في تشكيل حركة ما.
- التغييرات في نظام الاتصالات داخل المجتمع
ج) العوامل الخارجية
وفيما يخص الملامح العامة للحركات الاجتماعية والسياسية فيمكن رصدها كما يلي:
- الارتباط بالتغيير الاجتماعي
- البناء الفكري المتميز
- البناء التنظيمي الضعيف والتضامن الداخلي القوي
- الاستمرارية وسرعة الانتشار والتغلغل التلقائي
- عدم الاستقرار والتذبذب والتطور من وقت إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى
أسباب التطبيق وخصائص الحركات الاجتماعية والسياسية*
في البداسة سنركز على معرفة الدوافع والأسباب في تناول الحركات الإسلامية على أنها حركات اجتماعية وسياسية. والحقيقة أن هناك أسباب كثيرة تبرز هذه النظرة. ومن أصحاب هذا الرأي د. على الدين كتب "أن الحركات الإسلامية هي تأكيد أو إثبات الصور التقليدية للفهم والسلوك في بيئة تتغير جذريا، وأنها على عكس الآراء، تؤكد أن الأمور يمكن أو يجب أن تمضي كما كانت عليه في الأجيال السابقة، فإن الحركات الإسلامية تدرك أنها تتحدث إلى بيئة متغيرة ومناخ مختلف من التوقعات. وقد تكون هذه الحركات معارضا أعمى لكل التغيير الاجتماعي، ولكنها تصر على أن التغيير يجب أن يكون محكوما بالقيم وصور التفكير التقليدية: وهي رؤية تجد جاذبية لدى الشرائح المتعلمة من الناس الحريصين على استعادة مجد الإسلام، وإنها ليست "الديانة الشعبية" للأميين، بل وسيلة لتعبئتهم، كما أنها تجد جاذبيتها عند الجماعات التي اهتز دورها ونفوذها بسبب عملية التغيير الاجتماعي".[7]
ونظر د. سعد الدين ابراهيم النظرة نفسها، واستنتج من الملاحظة الميدانية أن الحركات الإسلامية تسعى إلى بناء نظام اجتماعي جديد قائم على الإسلام وتحدث في دراسات أخرى عن العوامل المؤثرة في صعود هذه الحركات مشيرا إلى مسائل مثل الهوية، والتحديث، والميراث الثقافي، والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة السياسية، والسيطرة الأجنبية ثقافيا وسياسيا.[8]
ومن جهة أخرى فإن تناول الحركات الإسلامية كحركات اجتماعية وسياسية يجنب الباحث مَزالق التعميم والأحكام المسبقة وأوجه الغموض التي اتسمت بها دراسات شتى صدرت عن ظاهرة الإحياء الإسلامي، كما أنه قد عكست بعض الدراسات الغربية نظرة تجزئيئة للإسلام وطرحت معان مختلفة للمفهوم الواحد، وركزت على مجموعة من المفاهيم ذات الدلالات السلبية، خاصة الربط بين الإسلام والعنف. هذا فضلا عن الترويج لمفهوم الأصولية الإسلامية الذي شاع وسبب جدلا واسعا.[9] ولكن دراسة الحركات الإسلامية كحركات اجتماعية وسياسية تركز على كونها قوى سياسية في المجتمع لها أهدافها وخصائصها المتميزة واستراتيجيتها وتتأثر بالظروف الاقتصادية واجتماعية والسياسية والفكرية السائدة، شأنها في ذلك شأن أية قوى سياسية أخرى. وما صفة "الإسلامية" في هذه الحالة سوى تعبير عن الإطار الفكري الذي تنطلق منه هذه الحركات فهي في حقيقة الأمر حركات اجتماعية وسياسية في مجتمعات إسلامية.
ومن جهة ثالثة، فإن إعادة اكتشاف الإسلام وتفسير أسباب انتشار الحركات الإسلامية يتحقق بصورة أكثر موضوعية بتحليل هذه الحركات الإسلامية كحركات اجتماعية وسياسية، لا بتناول ظاهرة الإحياء الإسلامي على إطلاقها، خاصة أن كثيرا من الدراسات الغربية أسقطت أحكامها العامة بالنسبة لظاهرة الإحياء الإسلامي على الحركات الإسلامية دون مراعاة للتباين بين الموضوعين وللتباين داخل الحركات الإسلامية ذاتها. ومن هذه الزاوية أصبح الباحثون مهتمين بإعادة النظر في نظرية الحداثة، وفي الأحكام القديمة الرافضة للحركات الدينية كحركات مهمة في التغيير الاجتماعي. والمعروف أنه إلى وقت ليس ببعيد انتهى كثير من الباحثين الغربيين إلى إخراج الإسلام كقوة فعلية من دائرة التطور السياسي والاجتماعي للمجتمعات الإسلامية والعربية وذلك بعد أن دخلت هذه المجتمعات مرحلة انتقالية إلى الحداثة. وقال هؤلاء إن انتقال هذه المجتمعات من الطبيعة التقليدية إلى الحداثة يعني سقوط الإسلام كإطار أو أيديولوجية مناسبة للتطور، أو على الأقل إنه سيصبح عاملا لا جدوى أو لا نفو منه لتطور هذه المجتمعات.[10]كما ركز فريق من الباحثين على تناول الإسلام من جوانبه الثقافية والعقيدية دون النظر إلى أنه قوة اجتماعية وسياسية. ولكن مع صعود موجة الإحياء الإسلامي منذ عام 1979 ظهر الإسلام كقوة للتغيير سواء على مستوى الأيديولوجية أو الممارسة السياسية، واعتبر أسلوبا للحياة الاجتماعية لكثير من المسلمين.[11] فأصبح مصدرا لحركات سياسية شتى بل مالت النظم السياسية في المجتمعات الإسلامية إلى إدراجه ضمن توجهاتها وأساليبها في إدارة البلاد.[12]
هذا وتطور في الخمسينيات فرع داخل الإطار العام لعلم الاجتماع يبحث بصورة علمية في الظاهرة الدينية بمعناها الواسع، وسمي هذا الفرع بعلم اجتماع الدين. ويسعى هذا العلم لا لتأمل الظاهرة الدينية في محتواها، وإنما لبحث طبيعتها ودورها اجتماعي والتغيرات التي تعتري هذه الطبيعة وهذا الدور في سياق التطور التاريخي. وبينما تهتم المعرفة العلمية بالظاهرة الدينية كنشاط إنساني فإنها تولي اهتماما خاصا بالجانب السياسي لهذا النشاط وما يترتب عليه من سمحها بإمكانية إخضاع الفكر الديني للتفكير السياسي والاجتماعي. ومن هنا مثلا يرتبط فكر ديني معين بنمط اجتماعي واقتصادي في فترة زمنية محددة ويتغير بتغيره. فمن هذه الخاصية تستمد الحركات الدينية خصائص أخرى تميزها عن غيرها وهي قدرة الدين على إعادة توجيه شخصية وسلوك الفرد جذريا، وادعاء الحركات الدينية أنها تحظي بأولوية على غيرها وسط الأيديولوجيات المختلفة بالنظر إلى كونها الوحدة التي تحتكر طرح الحقيقة الأيدولوجية سواء عن طريق الوحي أو العقل، حيث قدرة الدين على إحداث الاندماج والتضامن اجتماعي.[13]
ومن متابعة التطورات السياسية التي لحقت بالمجتمع الإسلامي منذ بداية عهد الخلفاء الراشدين وحتى الوقت الراهن، يمكن القول أن مظاهر التعبير عن الأهداف والمصالح لبعض الجماعات اتخذت شكل الحركات الاجتماعية والسياسية. فموجات الإصلاح وحالات الثورات التي عرفتها النظم السياسية الإسلامية ما هي إلا صور لنشاط حركات إسلامية مختلفة. وقد شهد تراث الإسلام ظهور جهود جماعية متنوعة تنشد التغيير، انطلقت بتلقائية في مجتمعاتها واتسمت بالانتشار والتغلغل، بعضها كان منظما والآخر أقل تنظيما أو منعدم التنظيم، سعت هذه الجهود جميعا إلى تحقيق أهداف معينة في التغيير الاجتماعي والسياسي. وكان لهذه الجهود الجماعية رموزها وقياداتها. فيمكن القول بأن بعضها كان ثوريا، والآخر إصلاحيا.
وكانت هذه الجهود هي شكل الاستجابة من جهة جماعات مختلفة لأزمتين حادتين واجهتا المجتمع والنظم الإسلامية منذ القدم، وهما الأزمة الروحية، أو الأزمة اجتماعية والسياسية، أو بمعنى آخر كيفية الحفاظ على العقيدة الدينية والجوانب الأخلاقية المرتبطة بها، وإقامة دولة إسلامية تنشد العدل والمساواة. ونشأت الأزمتان من تداخل أسباب ثلاثة دفعت جماعات مختلفة لطلب الإصلاح أو الثورة هي: اهتزاز العقيدة، والفساد والجور، والتهديدات الخارجية. وقد نتجت عن هذه الأسباب الثلاثة عوامل مباشرة قادت إلى ظهور حركات بعينها لها خصائصها المتميزة عن بعضها بعضا. ومن هذه العوامل اهتزاز القيم والمعايير، وانتشار حالات القلق الاجتماعي، ووقوع الحرمان والسخط والإحباط.
فمن ناحية أولى كان هدف التغيير الاجتماعي والسياسي قاسما مشتركا للحركات الإسلامية على مدى الزمن، حيث يشير تراثها الفكري إلى رفضها للأوضاع القائمة في المجتمعات والنظم الإسلامية باعتبارها أوضاع تخرج عن الإسلام الصحيح من وجهة نظرها، وتركز جهدها على إقامة الإسلام كنظام شامل للحياة الاجتماعية والسياسية للمسلمين. ومن ناحيلة ثانية فإن الحركات الإسلامية على خلاف طبيعة الحركات الاجتماعية والسياسية حظي معظمها ببناء تنظيمي قوي وليس ضعيفا. وربما يرجع ذلك إلى طابع السرية الذي اتسمت به الحركات الإسلامية عبر الزمن، ولقوة الاعتبارات الأيديولوجية والإصرار على تحقيق التغيير الاجتماعي الجذري ولبطش الحكومات الإسلامية بغالبية الحركات الإسلامية الرافضة.
و من ناحية ثالثة توفرت للحركات الإسلامية خاصية الانتشار والتغلغل التلقائي، وساعدتها في ذلك بوجه خاص طبيعة الدين الإسلامي ذاتها التي تفرض على المؤمن الحق أن يبادر بتطبيق تعاليم الإسلام دون توجيه، وقوة الشعور الروحي عند المسلمين مما يسهل تقبل الدعوات الإسلامية. وقد تحققت هذه الخاصية في الماضي والحاضر على حد سواء، فقد امتدت حركات الخوارج والشيعة ومثلا إلى خارج مواطنها الأصلية. ومن ناحية رابعة فجميع هذه الحركات تنطلق من تراث فكري إسلامي عريض ومتنوع، والاجتهادات في تفسير الإسلام كثيرة، فلم يعرف التاريخ الإسلامي زوال كامل لكل ما ظهر منذ عهد النبوة من تيارات إسلامية فكرية. وتعتبر الحركات الإسلامية استمرارها نجاحا في حد ذاته، حتى وإن لم تحقق أهدافها الفكرية، وذلك لاعتقادات بأنها تؤدي دورا ساميا أو رسالة مقدسة من أجل تطبيق الإسلام.
وإذا كان النجاح الحقيقي للحركة الاجتماعية والسياسية عموما يتمثل في قدرتها على تعميق الاقتناع لدى أعضائها بالمصلحة المشتركة من وراء التغيير الاجتماعي، فإن ذلك يتوفر بشكل أوضح في الحركات الإصلاحية والثورية والتي لا تخرج الحركات الإسلامية عموما عن أن تكون واحدة منها. والمقصود بالاقتناع هنا الشعور بأن مصلحة الجماعة أو الحركة تتفق مع القيم والمبادئ السامية أي حائزة لرضا الله، ومن ثم فأن نجاحها مقطوع به ولو بعد حين. والوجه الآخر لشعور الحركة الإسلامية بقدسية رسالتها هو اعتقادها في انحراف المعارضين لها عن الصواب. وتاريخ الحركات الإسلامية لا يخرج عن هذه الملاحظة فهي تربى أعضاءها على قوة الإيمان بصدق الرسالة التي يؤدونها، وبأن هناك مردودا إيجابيا سيعود على العضو من تطبيق أهدافها يتمثل في رضا الله قي الآخرة، وتطبيق تعاليم الإسلام باعتبارها واجبا لا يكتمل إسلام المسلم إلا به*. ونظرا لنجاح الحركات الإسلامية في هذا المجال فهي تستمر وتتجدد عبر الزمن.
محددات نشاط الحركات الإسلامية*
اختلفت نظرة الباحثين في تفسير نشاط الحركات الاجتماعية والسياسية باختلاف ما وضعوه من متغيرات تحكم موقف هذه الحركات، وحسب مجال اهتمام الحركة أي ما إذا كان محدودا أو واسعا، وباختلاف الاستراتيجية التي تتبعها الحركة، أي ما إذا كانت ذات طبيعة إصلاحية أم ثورية. وقد طرح تشارلز تيلي في كتابه "من التعبئة إلى الثورة" نموذجا عرض فيه لأهم المتغيرات التي تتحكم في "العمل الجماعي" من خلال وصفه للإستراتيجية التي تستخدمها الحركات اجتماعية لبلوغ أهدافها.[14]وبرغم أن تعريف مفهوم العمل الجماعي يتسم بالعمومية الشديدة حسبما أوضحه تيلي نفسه بأنه يعني عمل مشترك من أجل تحقيق أهداف مشتركة، إلا أن تيلي فضل هذا المفهوم على مفاهيم الاحتجاج أو التمرد أو الاضطراب، لأنه يرى أن استخدام هذه المفاهيم ينطوي على حكم مسبق بأن هذه الحركات تنوي الاتجاه إلى العنف.
ويرى تيلي أن هناك خمسة متغيرات كبرى تتحكم في العمل الجماعي هي المصلحة والتنظيم، والتعبئة، والفرصة، والعمل الجماعي نفسه. وفي المصلحة ركز تيلي على أوجه المكسب والخسارة الناجمة عن تفاعل حركة ما مع حركات أخرى. وفي التنظيم اهتم ببناء الحركة الذي يؤثر مباشرة على قدراتها العملية لتحقيق مصلحتها. وأما التعبئة فقد أشار إلى أنها العملية التي بمقتضاها تكتسب الحركة السيطرة على الموارد التي تحتاجها. وأوضح أن ما يعنيه في تحليله للفرص هو العلاقة بين الحركة والعالم المحيط بها، وأما العمل الجماعي فهو يتكون من عمل الأعضاء مجتمعين في اتجاه السعي نحو المصالح المشتركة كما أوضح أن العمل الجماعي ينتج من المزج بين المتغيرات الأربعة السابقة.[15]
وقام تيلي بتعريف هذه المتغيرات فأوضح أنه يقصد بالمصلحة إدراك أعضاء الحركة لما سيعود عليهم من نفع أو خسارة نتيجة تفاعلهم مع الجماعات الأخرى، وما يتطلعون إلى تحقيقه من وراء التغيير الاجتماعي. و يقصد بالنتظيم الهوية المشتركة والبناء الموحد بين أعضاء الحركة، وهو يمثل محصلة تعريف الأعضاء لأنفسهم، وتعريف الآخرين لهم باعتبارهم يشكلون مجموعة متميزة. وأما التعبئة فهي العملية التي بمقتضاها تنتقل الجماعة من كونها تحالف سلبي بين أفراد إلى المشاركة الإيجابية في الحياة العامة.
وفيما يتعلق بالجزء الثاني من النموذج، أوضح تيلي أن المقصود بالقمع - التسهيل هو عمل من جانب حركة أو جماعة أو حكومة أو قوة سياسية أخرى تزيد من تكلفة العمل الجماعي للحركة موضع التحليل. ويذكر أنه إذا كان الطرف الآخر المواجه للحركة هو الحكومة فأننا نطلق على القمع أو التسهيل وصف السياسة. وقد أشار تيلي إلى شكل آخر يقع بين القمع والتسهيل سماه بالتسامح. ويرى تيلي أنه كلما اتسع مجال عمل الحركة كلما كانت أكثر عرضة للقمع، كما أنه كلما زادتقوة الجماعة أصبحت أقل عرضة لاحتمال القمع. ويميز في إطار متغير القوة بين عنصرين مهمين هما الكفاءة والفعالية. [16]
وأخيرا يأتي متغير الفرصة-التهديد. ويقصد تيلي بالفرصة الوضع الذي يتاح أمام الحركة الاجتماعية وتستطيع استثماره بما يكسبها قوة إضافية. وهنا يشير تيلي إلى أن الفرصة تتعلق بالمطالب الجديدة للحركة والتي تهتم بتحقيقها وتكون حساسة تجاه التوصل إليها.
أولا: المحددات الداخلية
وتتضمن البناء الفكري، والبناء التنظيمي، والموارد. ويشتمل البناء الفكري على أربعة متغيرات هي: الأيديولوجية، ويقصد بها المقولات الفكرية، وتقوم الأيديولوجية بوظيفة تحديد الأهداف، وتحقيق التضامن الداخلي للحركة والتميز عن الآخرين. والمتغير الثاني هو مطلب التغيير الاجتماعي والسياسي. وقد يكون هذا التغيير محدودا أو شاملا. وفي حالة الحركات الإسلامية موضع البحث فإن التغيير الذي تتبناه يتسم بالشمولية. ولكنها في حقيقة الأمر لا توضح اتجاه التغيير الذي تطلبه، بمعنى أنها تكتفي بإطلاق مبدأ التغيير على مستوى المجتمع ونظام الحكم دون أن توضح نوعية السياسات لحل المشكلات التي تثيرها. والمتغير الثالث هو الرغبة في الانتشار والاستمرار، وغالبا ما أدى هذا الرغبة إلى مراجعة لأساليب النشاط من حين إلى آخر باتباع المراوغة، أو المهادنة أو الدفاع أو الهجوم حسب تقدير الحركة لقوتها في فترة زمنية معينة ولمصلحتها المشتركة. والمتغير الرابع هو الإستراتيجية التي تتبعها الجماعة لتحقيق الأهداف، ولا تخرج الحركات الإسلامية عن اتباع إحدى إستراتيجيتين: إما الإصلاح أو الثورة. ويتعين التوضيح في هذا الموضع أن الحركات الإسلامية عموما تهدف إلى إحداث تغيير جذري في بنية المجتمع والنظام السياسي بطرح بديل إسلامي لما هو قائم من قيم وأسس لنظام الحكم، ولكنها تختلف في كيفية تحقيق التغيير وحجمه حسب الزمن. فبعضها يؤمن بتحقيق التغيير على مراحل وبخطوات جزئية. ومن هنا برز وصف الإصلاح على توجهاتها. وبعضها يطالب بتحقيق التغيير الشامل فورا ودون انتظار حتى لو أدى ذلك إلى استخدام القوة ومن هنا تكتسب سمة الجذرية أو الثورية.
وأما من حيث البناء التنظيمي، فإن أول المتغيرات هو الهيكل النظمي الذي يتوقف شكله على طبيعة فكر الحركة وإستراتيجيتها، فكلما كانت الحركة أكثر رغبة في الاهتمام بجانب الدعوة الفكرية وتحقيق التغيير على مدى زمني أطول، كان بناؤها التنظيمي متسما بالمركزية الشديدة. وكلما كانت الحركة أكثر ميلا إلى الإسراع بالتغيير، اتسم بناؤها التنظيمي باللامركزية. وثاني هذه المتغيرات هو الدور المحوري للقيادات في الحركات الإسلامية. ففي الحركات الأكثر نشاطا والراغبة في التغيير السريع والجذري يكون الدور البارز للقيادات العملية وليس للقيادات الفكرية. ثم فالحركات التي تبغي إحراز النجاح السريع وتتبنى العنف تشهد ازديادا وتنوعا في القيادات لحاجتها الماسة لقيادات حركية بارزة تجمع التنظيم متسما بالحيوية والفاعلية. وأما الحركة التي تسعى لتحقيق أهدافها على مدى زمني أطول فإنها غالبا ما تتسم بقيادة مركزية وكاريزمية واحدة ولا تسمح بتنوع وتعدد القيادات.
ثانيا: المحددات الخارجية
وفيما يتعلق بالمحددات الخارجية فإنها تشمل: أولا: العلاقة مع السلطة الحاكمة. وتتضمن هذه العلاقة ثلاثة متغيرات هي التعاون والتهديد والتمرد ويتوقف أي منها على اعتبارين: الأول هو حجم الفرص التي تتيحها السلطة للحركات القائمة، والثاني هو مدى تهديد الحركات للسلطة الحاكمة أو تحدي الحركات لها مما يشمله من رفض الانصياغ لقوانينها ومباشرة ألوان مختلفة من النفوذ تشكل تهديدا للسلطة الحاكمة. وثانيها متغير العلاقة فيما بين الحركات الإسلامية ذاتها، وثالثها متغير العلاقة مع القوى السياسية الوطنية الأخرى وتتراوح هذه العلاقة في حالة الحركات الإسلامية بين من يعترف بدور هذه القوى، ومن يرفض التعامل معها ويتهمها بالكفر.
الحركات الإسلامية: النشأة والمدلول وملابسات الواقع
خلفية تاريخية - فكرية*
ليست قضايا التجديد والبعث الديني بالأمر الطارئ على التجربة الإسلامية، لا تاريخيا ولا فكريا؛ إذ تعتبر العقيدة الإسلامية البعث والتجديد والإحياء جزءا أصيلا من مسلماتها، بدءا باعتبار الإسلام نفسه بعثا للملة الحنيفية الإبراهيمية، وتجديدا لما اندرس منها بفعل الانحرافات التي اعترت الديانات السماوية، وانتهاءً بتأكيد النصوص الإسلامية المتكررة ضرورة حماية الدين من الاندثار والانحراف إذ تشمل مقومات الحماية العلم والتعلم، والذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، ومراجعة النفس، وكل ما من شأنه الحماية ضد الانحراف والنسيان، وتدارك ذلك متى ما وقع. إذن ظاهرة البعث والتجديد وما ارتبط بها من دعاوى ليست جديدة ولم تظهر في هذا العصر فقط.
وقد ظل تاريخ الإسلام حتى عهد قريب يشهد دعوات متكررة ينصِّب القائمون عليها أنفسهم مدافعين عن الدين ضد كل خطر وانحراف، مع إدانة المجتمع أو الدولة بالانحراف الذي يحتاج إلى تقويم وإصلاح. واستمر هذا الأمر حتى فجر الحداثة، حين ظلت أنحاء دار الإسلام تشهد هبات إصلاحية تهدف إلى إصلاح ما انهدم من شأن الدين وبعث ما اندثر من أمره. ومن هذه الحركات حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد (1703-1791) والحركة السنوسية في شمال إفريقيا (1859-1878) والمهدية في السودان (1881-1898) وحركة دان فوديو في نيجيريا (1754-1817) والدهلوية في الهند (1702-1762)، وغيرها في بقاع أخرى كثيرة من العالم الإسلامي. وقد سبقت هذه الحركات التي غلب عليها الطابع السياسي ولحقتها حركات أخرى كثيرة روحية واجتماعية، منها نشأة وانتشار الطرق الصوفية: الخلوتية والإدريسية والتجانية والسمانية والختمية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وعودة الروح إلى طرق صوفية قديمة شهدت انبعاثا وسعة انتشار، مثل النقشبندية والشاذلية والقادرية وغيرها.
ولكن كل هذه الحركات التي سبقت الحداثة تمتاز بأنها حركات جعلت الهم الديني أساس عملها ولب أهدافها. ويشمل ذلك حتى الحركات التي اتجذت منحى سياسيا مثل السنوسية والمهدية والوهابية. ولم يكن من بين هموم هذه الحركات لاضطلاع بإصلاح اقتصادي أوسياسي أو اجتماعي، إلا بقدر ما يكون مثل هذا الإصلاح من مطالب الدين وتطبيقا لقيمه أو تعاليمه. وهذا يعني أن المرجعية في الأمة الإسلامية كانت داخلية حتما، ودينية إلى حد كبير؛ إذ كانت تسعى حركات الإصلاح إلى إصلاح شأن الأمة الديني والدنيوي من منظور إسلامي بحت. غير أن هذه الخاصية بدأت تتأثر بعد مواجهة الأمة مع الحداثة، والتي كانت في مبدئها مواجهة عسكرية مع القوى الأوربية الصاعدة. وشهدت هذه الفترة تحول الأمة الإسلامية تدريجيا من القوة العظمى المستقلة بشؤونها والمهيمنة على محيطها إلى مجرد قوة بين القوى الكبرى، ممثلة في الدولة العثمانية وبدرجة أقل في مصر بقيادة محمد علي، وهي مكانة سرعان ما فقدتها بانهيار الدولة العثمانية ثم وقوع أغلبية الدول الإسلامية الأخرى تحت نير الاستعمار تباعا. كان الاستعمار تجربة جديدة تماما على الأمة الإسلامية التي واجهت قبل ذلك كثيرا من المحن والزرايا، بما في ذلك الاجتياح المغولي والصليبي وفقدان الأندلس والحروب والفتن والانهيار والتأكّل لنظامها المثالي. لكن آيّا من تلك الانتكاسات لم تزعزع ثقة الأمة بنفسها كما زعزعتها فترة الهيمنة الأوربية. فالمغول لم يقدموا نظرة بديلة للكون والحياة، ولم يكن لهم زاد سوى العنف الأعمى. أما الصليبيون فلم يقدموا شيئا جديدا غاب عن المسلمين، أو نظرة لم يكن أمرها محسوما في العقيدة الإسلامية، بينما لم يختلف نهجهم البربري كثيرا عن سابقيهم من المغول. ولهذا لم تواجه الأمة فتنة بسبب هذه المواجهات، ولم يكن يساورها شك في انتصارها الحتمي على الأعداء، وبالفعل جاء هذا النصر في الأغلب ساحقا وكاملا.
ولكن شيئا بدأ يتغير في القرون الثلاثة الأخيرة، وتغير معه وعي الأمة بنوعية التحديات التي أخذت تواجهها. وكان التركيز في بداسة الأمر على التحديات العسكرية، حيث اتجه النظر إلى تحديث الجيوش وتسليحها وإعادة تنظيمها. ودخل في هذا الباب التدريب، والتزود بالعلوم الحديثة في مجالات الهندسة والطب وغيرهما. وتطور الأمر إلى التوسع في دراسة العلوم وإرسال البعثات إلى الغرب، وأدى هذا بدوره إلى اطلاع أوسع على ما ظن البعض أنه خلفيات التفوق الأوربي، ومن هنا بدأ البعض يعبر عن آراء معادها أن الأمر لا يتعلق بالتفوق العسكري فقط. وما لبث الافتتان الأولي بالنموذج السياسي الغربي (رفاعة الطهطاوي 1801-1873) أن تحول إلى تأملات عميقة في أسرار نجاحه (خير الدين التونسي 1890)، ثم إلى تمثل أيديولوجياته في حركات فكرية وسياسية، بدءا بالحركة القومية في تركيا ومن ثم في العالم العربي، ثم الحركات الدستورية في إيران.
ولم يَطل العهد قبل أن يُطل عصر الثورات، بدءا بثورة أحمد عرابي في مصر عام 1882 ثم انقلاب حركة الاتحاد في تركيا عام 1908، ثم "الثورة العربية الكبرى" عام 1916، ثم تلك السلسلة اللامتناهية من الانقلابات والثورات التي ما زلنا نعيش ذيولها. وبدأ على المستوى الفكري أيضا تثور تساؤلات متعددة الأبعاد، كان من أبرزها وأعمقها تلك التي طرحها جمال الدين الأفغاني (1839-1897) الذي كان يرى أن ضمور الفكر الفلسفي في الساحة الإسلامية هو سبب تأخر الأمة العلمي. وطرح الأفغاني أيضا تساؤلات حول فهم الدين، والتي رددها بعض معاصريه وكثيرون بعده، وتركز معظمها حول ضرورة إعادة النظر في المفاهيم الدينية السائدة، والرجوع إلى أصل الإسلام الناصع كما عرفه السلف الصالح. وتضمنت هذه التساؤلات محاولات لاستيعاب الأفكار والمؤسسات الجديدة التي نالت إعجاب المفكرين المسلمين مثل الديموقراطية والبرلمان والمؤسسات الاقتصادية الحديثة وما إليها. والملاحظ هو أن الهم المركزي لكل هذه الحركات الفكرية والإصلاحية والثورات والانقلابات والاضطرابات كان تحديدا محنة المسلمين الدنيوية: تخلفهم وضعفهم وفقرهم وتراجعهم أمام الآخرين وإلخ.
ولعل أبرز ما ميز هذا العالم الجديد كان الوعي بوجود عوامل وأبعاد ورؤى أخرى غير تلك التي عرفها الأسلاف؛ إضافة إلى التأثر بهذه العوامل الجديدة، إن لم يكن التعاطف معها والتوق إلى أن يكون المسلمون جزءا فاعلا فيها. وهذا هو العالم الذي برزت فيه الحركات الإسلامية الحديثة وبدأت تأخذ شكلها في إطاره.
الحركات الإسلامية: النشأة*
يمكن – أذا عدنا إلى نقاشنا الأول حول تعريف الحركات الإسلامية الحديثة – أن نقول إن أبرز السمات المميزة لهذه الحركات هي حداثتها. فهي حركات نشأت في كنف الحداثة واستجابا لتحدياتها. وهي أيضا إسلامية بمعنى أنها اختارت استجابةً لتحديات الحداثة المرجعية الإسلامية، ولا تنطلق مثل غيرها من منطق الفعالية المجردة، ولا تستند إلى قيم وأيديولوجيات أخرى تتعارض مع هذه المرجعية، أو تعتمد مرجعية من خارجها. كانت هذه الحركات إذن – وإلى حد كبير – وليدة هذا العالم الجديد الذي يعتبر الخروج عن الإطار الإسلامي التقليدي، وبمعنى آخر ثنائية "الحداثة-العلمنة" إحدى أبرز مزاياه. وكان لا بد لهذه الحركات من أن تحمل ملامح هذا العالم الجديد، وتتشكل بشكله إلى حد كبير. ويكاد يكون هناك ما يثبته الإجماع بين المحللين في هذا المجال في نسبة الحركات الإسلامية المعاصرة إلى الجهد الفكري والإصلاحي الذي بذله جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده (1849-1905) وبدوره تلميذه هو الشيخ محمد رشيد رضا (1865-1935)، حيث أبرزا السمات التي ستميز الحركات الإسلامية فيما بعد، وبخاصة تأثرها بالحداثة مع رفضها لها في آن معا.
وقد أثر الأفغاني مباشرة بفكره في جيل كامل من المسلمين حيث كان له تأثير أوسع غبر مجلة "العروة الوثقى" التي أصدرها وتلميذه محمد عبده في باريس عام 1884. ورغم أن الرجلين أعلنا في المجلة عن إنشاء تنظيم إسلامي عالمي بالاسم نفسه وهو "العروة الوثقى" فإن يبدو أن ذلك التنظيم كان أمنية أكثر منه واقعا. وانتشر هذا التأثير عبر محمد رشيد رضا ومجلته "المنار". ولا شك في أن الجو العام الذي خلقته هذه المدرسة الفكرية، وهمومها ومبادئها الأساسية: مقاومة الاستعمار، واستعادة مجد الأمة، وإرساء أسس الشورى وإصلاح الحكم، والإصلاح الديني وتجديد الدين، شكلت كلها الأسس التي قامت عليها الحركات الإسلامية الحديثة.
وقد حرص الأفغاني على تمييز موقفه الفكري والسياسي عن التيارات الفكرية والسياسية الأخرى، وبخاصة تلك التي سعت إلى مهادنة الغرب وقبول هيمنته السياسية، أو تلك التي سعت إلى التخلي عن بعض التعاليم الإسلامية أو تطويعها ل"ملاءمة" الحداثة. فقد شن هجوما عنيفا على مدرسة "الحداثة" التي روج لها المصلّح الهندي أحمد خان، وانتقد سياسة مصر في ممالأة الانجليز وهاجم شاه إيران نصر الدين لتقديمه تنازلات للشركات البريطانية، بل حرض على قتله. ودعا كذلك إلى التمسك بالدين وإحيائه بالعودة إلى أصوله ومنابعه النقية. وتعتبر هذه المبادئ والتوجهات التي سار عليها من بعده تلاميذه عبده ورضا من أبرز الملامح التي ميزت فكر الحركات الإسلامية الحديثة وتوجهها. وقد أكد نظرية الاستمرارية هذه الفهم الذاتي لقادة الحركة الإسلامية أنفسهم فالإمام حسن البنا كان على صلة بالشيخ محمد رشيد رضا ولم يخف تأثره به.[17] ولكن هذه الدلائل على استمرارية يجب ألا تجعلنا نغفل عوامل الجدة والمفارقة في الحركة التي أنشأها حسن البنا في الإسماعيلية عام 1928. فقد نشأت تلك الحركة ومحمد رشيد رضا حي يرزق، وكانت العوامل التي أدت إلى إنشائها عوامل مباشرة، انطلقت من رؤية معينة للأزمة، وشعور بأن المؤسسات الإسلامية القائمة، بما فيها مجلة المنار ومدرستها، لم تعد قادرة على التصدي لهذه الأزمة. فقد انفعل البنا – كما ذكر – بما رآه في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى في مصر من تيار جارف لتأثير الغرب الفكري والثقافي والسلوكي والأخلاقي، ودفعه الشعور بالخطر إلى التحرك لاستنفار العلماء ورجال المؤسسة الدينية بهدف التصدي لتيار الفساد والانحلال هذا. إلا أن ردة فعلهم كانت مخيبة للآمال، مما دفعه إلى أن يتخذ مبادرات شخصية وفردية لمواجهة المشكلة، كان أبرزها ممارسة الوعظ الديني في المقاهي والطرقات العامة. وفي الإسماعيلية سرعان ما واجهته إشكالية نتجت عن هذا السلوك، وهي ماذا يفعل بمن يستجيبون لدعوته؟ وقد جاءت الإجابة أيضا عفوية، بدءا من الاستجابة لطلب بعض العمال هناك أن يساعدهم على تعلم شؤون الدين وممارسة الشعائر.[18] وهكذا بدأت تلك النواة الصغيرة وكبرت من هموم تعليم الصلاة والوضوء واتخاذ مسجد، إلى التصدي لقضايا أوسع، ثم إلى التوسع في العضوية وإنشاء الفروع حتى عمت كل البلاد، وبلغت العضوية عشرات، بل مئات الآلاف.
لقد كانت المؤثرات المحلية والظرفية نفسها هي العامل الحاسم في نشأة الجماعة الإسلامية في الهند على يد أبي الأعلى المودودي عام 1941. وقد بدأت مساهمة المودودي تقليدية، حيث تصدى للدفاع عن الإسلام ضد شبهات منتقصيه من الهندوس. ولكنه سرعان ما اتجه بالنقد إلى توجهات قيادات العمل الإسلامي في الهند، بداية بانتقاد دعوة المؤتمر القومي الهتدي إلى دولة علمانية استمرارية توحد بين المسلمين والهندوس، مؤكدا أن هذه الدولة لن تكون علمانية حقيقية، لأنها ستميل إلى الأغلبية الهندوسية، وهي على كل مرفوضة لأنها تلزم المسلمين بخدمة الدولة القومية ومبادئها لا الإسلام وعقيدته.[19] ومن هنا يكون المودودي متفقا مع الدعوة التي أطلقها محمد إقبال وحملتها فيما بعد الرابطة الإسلامية، وهي إقامة وطن قومي منفصل للمسلمين. ولكن المودودي أدخر نقده الأشد لهذه الحركة القومية. حسب رؤيته فإن دعوة الرابطة الإسلامية لإنشاء وطن قومي للمسلمين في الهند تناقض تعاليم الإسلام، ولا يمكن أن تفضي إلى إقامة دولة الإسلامية على المدى الطويل، كما يزعم أنصارها. والسبب هو أن الدعوة القومية تناقض الدعوة الإسلامية تناقضا جوهريا، ولا يمكن أن يكون انتهاجها خطوة نحو الإسلام، بل هي هرولة في الاتجاه المعاكس؛ فمبادئ الجامعة القومية تقوم على التجمع من أجل مصالح فئة محددة، تستأثر بخيرات الدنيا دون غيرها، بينما دولة الإسلام هي دولة الفكرة، وجامعته هي جامعة العقيدة.[20] ويتمثل الحل عند المودودي في أن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها، وأن النهج الذي اتبعه النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان نهج بناء الأمة أولا، ثم الدولة ثانيا. والطريق إلى هذا يتم عبر نواة طليعية من المؤمنين بالدعوة الإسلامية، تتولى جمع الناس حولها والثبات على أصولها إلى أن تنتصر الفكرة، وتثبت الجماعة بانتصارها على المحن جدارتها بحمل الراية. ومع انتصار الأمة على المصاعب والأعداء، تولد الجماعة ودولتها التي تكون الحاكمية فيها لله وحده عبر انتقال الشريعة.[21] ويسمي المودودي النموذج السياسي لهذه الدولة "الدمقراطية الإلهية" (theo-democracy)[22]، إشارة إلى أن الحكم فيها شورى بين الناس، ولكن المرجعية النهائية فيها هي حكم الله وشريعة الإسلام.
لقد توسعت الحركتان اللتان أنشأهما البنا والمودودي وانتشرتا وأصبح لهما شأن في بلاد المنشأ وخارجها. فأصبحت حركة الإخوان المسلمين من أقوى الحركات السياسية في مصر، إن لم تكن أقواها على الإطلاق. أما الجماعة الإسلامية في الهند فقد كسبت أيضا سندا شعبيا، وإن كانت اتخذت نهجا صفويا (نخبويا) يخالف إلى حد ما النهج الجماهيري لحركة الإخوان المسلمين. وقد وصل تأثير فكر المودودي إلى قلب حركة الإخوان المسلمين وعبرها إلى العالم العربي عن طريق كتابات سيد قطب الذي استقى جزءا مهما من أفكاره من المودودي، وبخاصة مفهوم جاهلية المجتمع ودور الصفوة في إرساء أسس المجتمع الإسلامي.
تعددت الاجتهادات في أسباب الانتشار الواسع الذي لقيته هذه الحركات في المجتمعات الإسلامية، وبخاصة بعد ما عرف ب"الصحوة الإسلامية" في السبعينيات والثمانينيات. وقد رأى بعض المحللين في هذا النجاح ثمار الطفرة النفطية وآثارها[23] مقرونا بالشعور بالخيبة من فشل الحكومات والأيديولوجيات العلمانية، إضافة إلى أزمة الهوية والشعور بالدونية تجاه الغرب[24]. وعلل آخرون هذا التطور بالرجوع إلى أزمات أخرى، بدءا من الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929، ومرورا بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي ضربت العالم الإسلامي في النصف الثاني من هذا القرن.[25] وقد واكب هذه الأزمات حدة الصراع الطبقي وعجز المعارضة العلمانية وإفلاسها. ويضيف غيرهم الرأي بأن هذه الحركات هي رد فعل دفاعي في المجتمعات الإسلامية التي دهمتها الحداثة وهددتها بالتفكك والانهيار.[26] وثمة تفسيرات مماثلة ترجع صعود الحركات الإسلامية إلى طبيعة الدين الإسلامي نفسه، وعدم قابليته للعقلنة والعلمنة. ويضيف بعض هؤلاء أن الحداثة عززت مركز الإسلام النصي (مقابل الشعبي) بدلا من أن تؤدي إلى انحدار نفوذه كما حدث للمسيحية.[27] ومن التحليلات التي تسير في هذا الخط تلك المقولات التي تُرجع صعود الأصولية إلى فشل المفاهيم التقليدية، إضافة إلى بدائلها الحداثية (محمد عبده وعلي عبد الرازق وطه حسين..إلخ)، في كسب الجماهير.[28]
تنتهج التفسيرات الغالبة في تحليلها وتشخيصها للظاهرة الإسلامية إذن، منهج التفسيرالاجتماعي للعلمانية، ولكن بالمقلوب. فيرى البعض أن هذا النهج التشخيصي الذي يستصحب فرض العلمنة ضمنا هو نهج مغلوط من أساسه، لكونه يتناول القضية بالمقلوب، فالسؤال الذي يجب أن يطرح هو ليس: لماذا نشأت الحركات الداعية للتمسك بالإسلام وازدهرت؟ وأنما هو: لماذا فشلت الجهود والضغوط الرامية إلى خلخلة التمسك بالمبادئ الإسلامية في المجتمعات المعنية؟ والإجابة هي أن أولئك الذين أرادوا تقديم بدائل للإسلام لم يقدموا للمسلمين حججا مقنعة تصدهم عن دينهم ولا إغراء فاتنا يصرفهم عنه ابتغاء منفعة عاجلة.
وينتقد آخرون هذه الآراء التي تزعم بأن العودة إلى الإسلام هي عودة إلى ما هو طبيعي، حيث يقولون أن كون قيادات الحركات الإسلامية في أغلبها من القطاع الحديث المتأثر بالغرب وليست من العلماء والمشائخ، وكون أتباعها ما يزالون أقلية، إضافة إلى انتهاج تلك الحركات العنف لتمرير برامجها يؤكد أن ما أتت به هو بدعة جديدة وليس اتجاها طبيعيا أو أصيلا في المجتمع كما تدعي.[29]
يرى محللون آخرون أن إشكال الحركات الإسلامية ينعكس في إخفاقها عن تحقيق أهدافها، وهو إشكال يشير بدوره إلى خلل بيِّن في فكر هذه الحركات وأيديولوجيايتها وبنيتها التنظيمية. وفي المرات القليلة التي اقتربت فيها جهات إسلامية من السلطة إما مباشرة وإما بتحالف مع قوى أخرى، كما كانت الحال في إيران وأفغانستان والسودان واليمن وماليزيا والكويت والجزائر، فإن حاصل هذا الاقتراب كان تعميق الأزمة في تلك البلدان لا تجاوزها... الخ.
يتمثل الإشكال في هذه التحليلات في أنها تخلط خلطا كبيرا بين إدانة فكر الحركات الإسلامية وممارستها وبين الحكم بأنها فشلت وآلت إلى الاندثار؛ إذ ظلت الأحكام باندثار الحركات الإسلامية تصدر بانتظام منذ الأربعينيات من القرن الماضي. حقيقة الأمر أن فشل كثير من الحركات الإسلامية في تحقيق برامجها هو في الواقع تعبير آخر عن نجاحها. ففي مصر والجزائر وكثير من الدول الإسلامية، نجد أن فكر الحركات الإسلامية صار هو المهيمن اجتماعيا إلى درجة أن الأحداث أخذت تتجاوزها. فقد أصبح لبس "الزي الإسلامي" مثلا والتزام الشعائر الدينية ظاهرة جماهيرية تتجاوز بمدى بعيد عضوية الحركة الإسلامية ودائرة تأثيرها المباشر. بل إن جماعات إسلامية عديدة نشأت وأخذت تزايد على الحركات الإسلامية المعروفة وتتهمها بالتهاون في أمر الإسلام. إذن ما زالت الحركات الإسلامية من أكثر القوى الفاعلة على الساحة السياسية.
خريطة تصنيف الحركات الإسلامية
وفقا لمحورية الأساس الفكرية السابق توضيحها، فإن الحركات الإسلامية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين لا يجمع بينهما سوى الانتساب إلى الإسلام مع الاختلاف العميق قبل ذلك وبعده في طريقة هذا الانتساب وقراءة ذلك الإسلام. إنه يمكن القول أن نظائر لتلك الحركات المتنوعة قد سبق لها الظهور والتواجد خلال القرون الخمسة عشر التي تمثل التاريخ الإسلامي، وأن بعضا من الحركات التي نشهدها حاليا ليست سوى "إعادة انتاج" لتلك الحركات القديمة. كذلك فمن الضروري التأكيد على أن خريطة الحركات الإسلامية المقترحة هنا لا تشمل سوى تلك التي ترتبط بعلاقة ما مع السياسة وفي مركزها السلطة والدولة أكثر من ارتباطها بالمجتمع والممارسات الاجتماعية والدينية الطقوسية.
الحركات الإسلامية الدينية*
وهي تلك التي تقوم على قراءة معينة للإسلام والنصوص القرآنية الكريمة تنظر من خلالها للأفراد والمجتمعات والدول من منظور صحة العقيدة فقط، في حين لا تلقى اهتماما يذكر إلى ما هو دون ذلك من مستوايات ومصادر فقهية وشرعية. والقضية الرئيسية وربما الوحيدة بالنسبة لتلك الحركات هي إقامة التوحيد والعبودية الحقة لله كما تراهما، وبالتالي فإن حقيقة الإيمان بالنسبة للأفراد والمجتمعات والدول يظل بالنسبة لها المبحث الوحيد الذي تتحرك ضمنه أفكار وأفعال تلك الفئة من الجماعات. بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم بتفسير تلك النصوص القرآنية والنبوية بطريقة حرفية ظاهرية، وتدفع تلك المنهجية ذلك الحركات بصفة عامة إلى التورط في أحكام متسرعة بكفر الدول وجاهلية المجتمعات والأفراد. وفضلا عن تلبس تلك الحركات في أسمائها ومصطلحاتها وتشكيلاتها التنظيمية وسلوك أعضائها للموروث الإسلامي من حقبة النبوة والخلافة الراشدة التي تمثل المرجعية التاريخية الوحيدة لها، فهي تقوم بقراءة واقع مجتمعاتها المعاصرة عبر تجربة تلك الحقبة وتعيد تسمية فاعليه وقواه وتناقضاته بنفس المسميات التي كانت فيها. وبذلك فإن الهدف الرئيسي لتلك الحركات هو إعادة أسلمة المجتمعات والدول – وكذلك الأفراد بالنسبة للبعض منها – حيث أنهم جميعا حسب رؤيتها خارجون عن الإسلام بصور مختلفة. وتنقسم تلك الحركات الإسلامية الدينية في تبينها للحقبة النبوية وما تلاها من الخلافة الراشدة وقياس المرحلة الحالية عليها إلى قسمين رئيسيين:
1- الحركات المتطرفة السلمية
تتفق تلك الحركات على أن المجتمعات المعاصرة أقرب لحالة المجتمع الجاهلي والكافر في مكة بعد البعثة النبوية وقبل الهجرة منها إلى المدينة، كذلك فبنفس القياس فتلك الحركات ترى أن الوقت لم يحن بعد للعمل بالسياسة أو بناء دولة إسلامية[30] أو ممارسة القتال – أو الجهاد حسب مصطلحهم – حيث أن كل ذلك لم يؤمن به المسلمون قليلي العدد والحيلة في مكة. نتيجة لهذا، تذهب تلك الحركات إلى عدم ممارسة أي أفعال عنيفة أو قتالية ضد المجتمعات والدول والأفراد الكافرين أو الجاهليين حسب رؤيتهم لهم مثلما لم يفعل ذلك المسلمون الأوائل في المرحلة المكية. أما عندما يطرح التساؤل بداخل تلك الحركات حول طريقة التعامل مع هؤلاء الأفراد والدول والمجتمعات، فإنهم ينقسمون بناءً على إجابته إلى قسمين رئيسيين:
أ) حركات التكفير والهجرة
إنها ترى أن المجتمعات المعاصرة تشبه مجتمع مكة قبل الهجرة مباشرة، حيث لم يعد فيها من أمل أن تهتدي للإسلام ولم تعد تضم سوى الكافرين فقط وبالتالي لابد لهم من هجرها بصورة أو بأخرى، حيث أنهم يمثلون المسلمين الوحيدين على وجه الأرض ومن سواهم ولم ينضم إليهم فهو كافر كفرا بواحا. والهجرة بالنسبة لهم، سواء كانت داخل المجتمع باعتزاله تماما والانفصال عنه كلية أو بالخروج منه إلى الصحارى والمناطق البعيدة، إنما هي على غرار الهجرة النبوية انتظارا لأن يظهر الله دينه ويعودوا إلى ذلك المجتمع منتصرين.
ب) حركات إعادة الدعوة
حيث أن دعوة – أو بعبارة أدق إعادة دعوة – الناس الموجودين فيها والذين يجهلون الإسلام كما كان الكافرون في مكة يجهلونه، تعد المهمة الوحيدة التي يجب عليهم القيام بها كما فعل المسلمون الأوائل. ويمثل "التبليغ والدعوة" تعاليم الإسلام الأساسية وأركانه وعباداته من دون تبين اساليب العنف.
2- الحركات الجهادية العنيفة
تتفق الحركات الجهادية العنيفة على أن المرحلة التي يعيشها العالم اليوم يمكن مقارنتها بمرحلة هجرة الإسلام إلى المدينة وما تلاها. وهي تلك التي اندمجت فيها العقيدة والدين بالدولة، أي بالسياسة. وتتفق تلك الحركات ايضا على أن الحكومات في البلدان المسلمة قد خرجت عن الإسلام وتعد مسئولة عن حالة الجاهلية التي تعيشها نجتمعات تلك البلدان وعن نحاربة قوى التوحيد، التي ترى تلك الحركات أنها تمثلها. ونتيجة لهذه القراءة فإن المجتمعات الجاهلية المعاصرة حسب تلك الحركات لا تجوز إعادة دعوتها إلى أساسيات الإسلام بعد أن وصل إليها البلاغ واكتملت الرسالة، وبالتالي فلا مكان للدعوة المكية الهادئة المتنامية بل هو "الاستعلاء" المدني وإعادة أسلمة المجتمع والدولة وتأسيسهما من جديد على نفس القواعد التي أسست عليها دولة المدينة. ويعد العنف الديني، أو الجهاد كما أسمته تلك الحركات، هو الوسيلة الوحيدة تقريبا لديها من أجل تحقيق تلك الأهداف. ونتيجة اختلاف ظروف ومراحل ومناطق نشأة تلك الحركات الجهادية العنيفة، فإنها توزعت بين أقسام ثلاثة على الأقل تتفق فيما بينها حول المفاهيم الأساسية السابقة ثم تختلف بعد ذلك في الأولويات الحركية لتطبيقها.
أ) الحركات محلية الطابع
تنطلق الحركات محلية الطابع، والتي لا توجد تقريبا سوى في بلدان العالم الإسلامي، من فكرة أن "العدو القريب أولى بالقتال من العدو البعيد"، وهو بالنسبة لها حكومات الدول التي تنتمي إليها والتي يعد إسقاطها عبر قتالها هو المهمة الأولى التي ينشدها العضو. وعلى الرغم من أن الجهاد هو فرض على المسلمين للدفاع من أي هجوم عليهم من عدو خارجي، فقد حورته تلك الفئة من الحركات الجهادية ليصير جهادا داخليا. ولا شك أن وضع تلك الفئة من الحركات مفهوم "الجهاد" عنوانا لقتالها الداخلي ضد حكوماتها إنما كان يعكس من ناحية رؤيتها لها باعتبارها حكومات "كافرة" معادية للإسلام. وقد كانت "الجماعة الإسلامية" و"جماعة الجهاد" في مصر، و"الجماعة الإسلامية المسلحة" في الجزائر و"الجماعة الإسلامية المقاتلة" في ليبيا الآن أمثلة بارزة لتلك الفئة من الحركات الجهادية محلية الطابع.
ب) الحركات الاستقلالية-الانفصالية
إنها متواجدة بصفة عامة في مناطق الأقليات المسلمة بداخل الدول غير الإسلامية، وأبرزها تلك التي توجد الآن في قشمير بالهند والشيشان بروسيا الاتحادية وفي أفغانستان أثناء الغزو السوفيتي لها. ويتداخل لدى تلك الحركات مفاهيم الجهاد ضد العدو الخارجي غير المسلم مع مفاهيم التحرر الوطني وتقرير المصير. بالإضافة لذلك تحتفظ تلك الحركات بالأساس الفكري لكل الحركات الخهادية والمتمثلة في اعتبارها أن مجتمعات أقاليمها تعيش في حالة الجاهلية وأن هدفها الأول بعد تحقيق استقلالها أو انفصالها هو إعادة أسلمتها وإقامة الدولة الإسلامية فيها.
ج) الحركات دولية المجال
إنها على اشتراك مع الفئتين الأخيريين في الأفكار الرئيسية لتلك الحركات لكنها تتميز عنها بتفسيرات أخرى خاصة لها هي مفهوم الجهاد وأولوية القتال "للعدو القريب أم للعدو البعيد" تحديدا. فتلك الفئة تتبنى مفهوم الجهاد الخارجي ضد من ترى أنهم أعداء الإسلام الخارجيين فتعتبر أن "العدو البعيد أولى بالقتال من العدو القريب"، بالرغم من اتفاقها مع الفئات الأخرى في النظر إلى "العدو القريب"، أي حكومات الدول الإسلامية، باعتبارها حكومات كافرة.
الحركات السياسية – الاجتماعية ذات البرنامج الإسلامي*
تتبنى تلك الحركات برامج سياسية – اجتماعية تقوم أساسا على مفهوم "الشريعة" التي هي في حقيقتها إنتاج بشري – وليس نص ديني مقدس – قام به مئات الفقهاء المسلمين متبايني المذاهب والاتجاهات والأماكن خلال قرون الإسلام الخمسة عشر لتحويل النصوص القرآنية والنبوية الكريمة إلى قواعد قانونية واجتماعية وسياسية لتنظيم الدول والمجتمعات المسلمة. ولا تتوقف المرجعية التاريخية لتلك الحركات عند المرحلة النبوية والخلافة الراشدة، بل تتسع لتشمل التاريخ الإسلامي وتراثه الموزع على قرونه مستعينة أحيانا على قراءته بمرجعيات أخرى من أمم أخرى خارجه. ويظل الإسلام بالنسبة لتلك الحركات بمثابة وعاء حضاري – ديني – تاريخي تستمد منه رؤاها لتنظيم المجتمعات والدول الإسلامية التي توجد فيها والتي تتخذ شكل البرنامج الذي لا يختلف سوى في المضمون عن برامج الجماعات السياسية – الاجتماعية الأخرى غير الإسلامية. إنها تنقسم بدورها إلى نوعين:
1) الحركات السلمية الساعية للحكم
هي تسعى بصورة مباشرة إلى السلطة السياسية من أجل تطبيق برنامجها السياسي والاجتماعي ذي الطابع الإسلامي الذي تعتقد أن غايته هي تحقيق التقدم والنمو لبلدانها ومجتمعاتها. ومن أجل وصولها لذلك الهدف تسلك تلك الحركات كافة السبل والوسائل السياسية السلمية المباشرة وغير المباشرة المتاحة أمامها، وتقوم بتغيير وتنويع مواقفها وتحالفاتها وصراعاتها مع الدولة أو القوى السياسية والاجتماعية الأخرى بحسب ما تقتضيه مصلحتها وتحقيق ذلك الهدف. وتعد جماعة الإخوان المسلمين في مصر والبلدان العربية الأخرى التي توجد بها فروعها، وجماعة النهضة في تونس، والجبهة الإسلامية للإنفاذ في الجزائر أبرز تلك الحركات السياسية – الاجتماعية السلمية الساعية للحكم.
2) حركات التحرر الوطني المسلحة
دفعت بها الظروف المحيطة بها في مجتمعاتها التي تخضع لاحتلال أجنبي إلى تبني برنامج للتحرر الوطني يقع الكفاح المسلح في القلب منه. وقد بدأ ظهور تلك الحركات من بين صفوف جماعة الإخوان المسلمين إبان حرب فلسطين عام 1948 ثم المقاومة الوطنية المصرية ضد قوات الاحتلال البريطاني في مدن قناة السويس بدءا من عام 1951 وفي الوقت الحالي، فإن كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وحزب الله اللبناني تعد الأكثر بروزا وتمثيلا لتلك النوعية من الحركات.
*مراجع الاستناد:
1) عبدالوهاب الأفندي، وآخرون، الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2002)، صص 13-49
2) د.علا عبد العزيز أبوزيد (محرر)، الحركات الإسلامية في آسيا (جامعة القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية، 1998)، صص3-30
3) ضياء رشوان (رئيس التحرير)، دليل الحركات الإسلامية في العالم (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بأهرام، 2006)، صص 6-24
[1] عبدالوهاب الأفندي، مرجع سابق، ص8
** أو تصنيفات عديدة أخرى من الباب: السلفية والأصولية والمتشددية والإرهابية والمتطرفية والنعتدلية والإسلاموية... إلخ
[2] د.علا عبد العزيز أبوزيد، مرخع سابق، صص3-5
[3]عبدالوهاب الأفندي، ورجع سابق، ص14
*د.علا عبد العزيز أبوزيد (محرر)، مرجع سابق، ص3
** د.علا عبد العزيز أبوزيد (محرر)، مرجع سابق، صص4 -5
[4] The Shorter Oxford English Dictionary 3rd ed. (London: Oxford University Press, 1955), p.1292; The New Encyclopedia Britannica, vol 10, p.922
[5] Richard T.Schaefer, Sociology, (New York: McGraw – Hill Book Company, 1983) p.520
[6] نقلا عن رفعت سيد أحمد، ظاهرة الإحياء الإسلامي في السبعينات: دراسة مقارنة لمصر وإيران، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
*د.علا عبد العزيز أبوزيد (محرر)، مرجع سابق، صص 14-21
[7] Ali E.Hillal Dessouki. The Resurgence of Islamic Organizations in Egypt: An Interpretation, in: Alexander S.Cudsi and Ali E.Hillal Dessouki (ed.), Islam and Power (London: Croom&Helm, 1981), p.108
[8] Saad Eddin Ibrahim, Islamic Militancy as a Social Movement: the Case of Two Groups in Egypt, in: Ali E.Hillal Dessouki (ed.) Islamic Resurgence in the Arab World (USA, Praeger 1982) and Saad Eddin Ibrahim, Egypt’s Islamic Activism in the 1980s, in: Third World Quarterly, vol 10, No.2 (April 1988), p.32
[9] انظر دراسة نقدية للدراسات الغربية حول ظاهرة الإحياء الإسلامي أعدها حسنين توفيق إبراهيم، وأماني مسعود الحديني بعنوان "ظاهرة الإحياء الإسلامي في الدراسات الغربية: رؤية تحليلية نقدية، مجلة منبر الحوار، العدد 25 صيف 1992، بيروت، صص6-38.
[10] Ali E.Hillal Dessouki (ed.), Islamic Resurgence in the Arab World, p.3
[11] Shireen T.Hunter. (ed.) The Politics of Islamic Revivalism (Indiana: Indiana University Press, 1988), p.7
[12]جيل كيبيل، يوم الله، الحركات الأصولية في الأديان الثلاثة، ترجمة نصير مروة (قبرص: دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث، 1992)، صص 12-13
[13]محمد السيد سعيد، "مقمدة لتشخيص الحركات الدينية والسياسية"، في المجلة الاجتماعية القومية، المجلد 23، عدد يناير مايو – سبتمبر 1986، صص30 و36
*بالمعروف والنهي عن المنكرالمقصود هنا الأمر
*د.علا عبد العزيز أبوزيد (محرر)، مرجع سابق،صص 21-27
[14] Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (Massachussetts: Adison-Wesley Publishing Company, 1978), p.84
[15] Charles Tilly, op.cit., p.7-8
[16]Charles Tilly, op.cit., p.115-98
*عبدالوهاب الأفندي، وآخرون، مرجع سابق،صص15-19
*عبدالوهاب الأفندي، وآخرون، مرجع سابق،صص19-31
[17]الإمام الشهيد حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية (القاهرة: المكتب الإسلامي، 1983)، صص253-254
[18]المرجع السابق، صص 72-76
[19] See Charles J.Adams, “Maududi and the Islamic State”, in John Esposito (ed.) Voices of Resurgent Islam (Oxford: Oxford University Press, 1983), p 100-104
[20]أبو الأعلى المودودي، منهاج الانقلاب الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة 1979). انظر أيضا: أبو الأعلى المودودي: الإسلام والمدنية الحديثة (القاهرة: دار الأنصار، 1978)
[21]المودودي، منهج الانقلاب الإسلامي، مرجع سابق
[22] See Abu L-Ala Maududi, Islamic Law and Constitution (Lahore: Islamic Publications, 1969)
انظر أيضا: أبو الأعلى المودودي: تدوين الدستور الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1975)
[23] See: Daniel Pipes, In the Path of God: Islam and Political Power )New York: Basic Books, 1983). And
Detleve Khalid, “The Phenomenon of Re-Islamisation,” Aussenpolitik no,29 (1978): 433-533
[24] See: Esposito, Voices of Resurgent Islam (Oxford: Oxford University Press, 1983), p 11-14
[25] حيدر إبراهيم علي، "الأسس الاجتماعية للظاهرة الدينية: ملاحظات في علم اجتماع الدين"، في: عبد الباقي الهرماسي وآخرين، الدين في المجتمع العربي (بيروت: مركز درايات الوحدة العربية، 1990)، صص 33-36
Mark Tessler,The Origin of Popular Support for Islamic Movements, in John P. Entelis (ed.) Islam, Democracy and the State in North Africa (Bloomington. IN: Indiana University Press, 1997), p.92-126
[26] صلاح الدين الجورشي، "الحركة الإسلامية مستقبلها رهين التغييرات الجذرية"، في: عبدالله النفيسي (محرر) الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية، أوراق في النقد الذاتي (القاهرة: مكتبة مديولي، 1989)، صص 117-147
[27]Ernest Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals (London: Penguin Books, 1994)
[28] عزيز العظمة، العلمانية من منظورمختلف، (بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية، 1992)، ص221-248
[29] Dale F.Eickelman and James Piscatori, Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 28-36
انظر أيضا: عزيز العظمة، مرجع سابق، ص 312
*ضياء رشوان، مرجع سابق،صص19-23
[30]للمزيد من المعلومات في هذا الخصوص انظر:مجدي حماد (وآخرون): الحركات الإسلامية والديمقراطية: دراسة في الفكر والممارسة (مركز دراسات الوحدة العربية، 2001) صص248-386
*ضياء رشوان، مرجع سابق،صص23-24
إن مجرد الحديث عن الحركات الإسلامية يلزم الباحث بمسلمات وافتراضات عدة، تبدأ من قبول الوصف الذاتي لهذه الحركات بأنها إسلامية، وتمر عبر رسم الحدود بين إسلامية هذه الحركات ولاإسلامية غيرها. فلا بد إذا قبل أن نشرع في تناول موضوع هذه الورقة من أن نتوقف قليلا عند المفاهيم والمصطلحات.[1] يطلق مصطلح "الحركات الإسلامية" (ويفضل بعض الباحثين مصطلح "الأصولية" ترجمة عن المصطلح الإنجليزي Fundamentalism، بينما يجنح آخرون إلى استخدام تعبير "الإسلاموية" ترجمة أيضا عن **Islamicist على الحركات التي تنشط على الساحة السياسية وتنادي بتطبيق قيم الإسلام وشرائعه في الحياة العامة والخاصة على حد سواء، وتناوئ في سبيل هذا المطلب الحكومات والحركات السياسية والاجتماعية الأخرى التي ترى أنها قصرت في امتثال تعاليم الإسلام أو خالفتها. ويغلب إطلاق هذا المصطلح على الحركات التي تصف نفسها بهذا الوصف وتنشط في مجال السياسة؛ إذ يندر مثلا إطلاق وصف الحركات الإسلامية على الجماعات الصوفية التي لا تنشط في مجال السياسة. ولا يطلق هذا الوصف عادة على الأحزاب التقليدية ذات الخلفية الإسلامية، مثل حزب الاستقلال في المغرب أو حزب الأمة في السودان، كما لا يطلق على النظم والحركات التي تحكم بالشريعة الإسلامية تقليديا كما هي الحال في المملكة العربية السعودية مثلا، بينما تطلق هذه الصفة على بعض حركات المعارضة لتلك الأنظمة. تعكس هذه الاستخدامات المسلمات النظرية الشائعة أو المستبطنة حول هذه الظاهرة، وطبيعة الفهم السائد إزاءها.
تبدو الحركاتُ الإسلامية إذ تميز نفسها عن التيار الشعبي العام، وتخصص هذا التمييز بنسبة نفسها إلى الإسلام، كما لو أنها تصدر حكما على المجتمع حولها بالتقصير عن الوفاء بقيم الإسلام، وتنصِّب نفسها قائما بمهمة التذكير والدعوة، وأحيانا الإكراه على تلافي هذا التقصير. وتتراوح ردود فعل القوى الأخرى تجاه هذه الدعاوى بين رفض مضمونها مع قبول أسسها (أي قبول التشخيص بأن المجتمعات لا تفي التدين حقه مع رفض دعوة الحركات الإسلامية في قيادة الصحوة لمرجوة) أو رفض الأسس والمضمون معا (القول إن المجتمعات هي إسلامية فعلا ولا تحتاج إلى من يذكرها بدينها)، أو قبولهما معا من منطلق مضاد تماما، شأن بعض المواقف العلمانية التي تقر بأن دور الدين في حياة المجتمعات تراجع كثيرا وأن الحركات الإسلامية تسعى إلى إحيائه، مع تأكيد أنها مهمة مستحيلة أو غير مرغوب فيها أصلا. ولا نريد في هذه المرحلة أن نحسم في أمر هذه الدعاوى أو الدعاوى المضادة، ولا أن نجزم بقول في مسألة التعريف حتى نستجلي بعض النقاط المتعلقة بالأساس النظري لهذا الحوار. ذلك أن كل حسم في هذه النقاط يستصحب موقفا نظريا أو قيميا معينا.
من الصعوبة الحديث بشكل تفصيلي وفي بحث واحد عن الحركات الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، إذ إن هذا الموضوع من الاتساع والتشعب بحيث لا يمكن إيفاؤه حقه إلا من خلال العديد من الأبحاث والدراسات.[2] لذا سأكتفي بتقديم عرض عام للحركة الإسلامية المعاصرة بشكل مختصر ومركّز حيث قد يبدو متجاوزا لبعض التفاصيل التي يعتقد البعض أنها في غاية الأهمية، وهذا ما لا أختلاف فيه مع أحد، ولكنني أحاول اختصار تجربة ما يقارب ثمانين عاما – منذ ظهور حركة الإخوان المسلمين، وعلى امتداد نحو عشرين دولة إسلامية – في بحث يهدف أساسا لكي يكون مدخلا عاما لفهم الحركة الإسلامية وما ينطوي عليه الموضوع من دوافع تأسيسها وتطويرها واتجاهات أيديولوجيتها.[3]
سأتناول في بداية الورقة تعريف عام للحركة الإسلامية بمثابتها حركة اجتماعية سياسية. ثم أتناول عرض أسباب قيامها الرئيسية وملامحها العامة، أنتقل بعد ذلك إلى تبسيط محددات نشاطها النموي. في الجزء الثاني من الورقة سوف أستعرض مقدمة موجزة عن نشأة الحركات الإسلامية المعاصرة وملابسات واقعها حيث أشير إلى عدة إشكالات في تصوير الغرب للخطر الكامن والقائم في الإسلام السياسي المرتبط باتسام بعض الحركات الإسلامية باستخدام القوة والعنف. ومن ثم ألتقي بعض الضوء على قضية رؤية الحركة الإسلامية للمفاهيم المتعلقة بالمشاركة السياسية. وأختتم هذه القراءة التشخيصية للحركات الإسلامية بتقديم خريطة انقسامها إلى حركات دينية وسياسية – اجتماعية ذات البرنامج الإسلامي.
إن الهدف الأساسي لهذا البحث هو تقديم عرض سريع وشامل لأهم المعلومات والاتجاهات المتعلقة بالحركات الإسلامية، وليست هذه كما ذكرنا بالمهمة اليسيرة وسط هذا الكم الهائل من الكتب والمقالات والجماعات والتطورات المتوالية. بأخذ ذلك في الاعتبار يكون الهدف من البحث في سياق هذه الدراسة متواضعا.
نحو تعريف الحركة الإسلامية
الحركات الاجتماعية والسياسية كمدخل للدراسة*
أجمع الكثير من علماء الاجتماع على أن الحركات الاجتماعية تعتبر بوجه عام ردود فعل لتغيرات بنائية في المجتمع، ومن ثم تكون مرتبطة بمتغيرات أخرى مثل التحولات في الاقنصاد والسكان والتكنولوجيا وبنية النظام السياسي ذاته؛ ويؤكدون أنه سواء تم النظر للحركات الاجتماعية على أنها عنصر هدم أو عنصر بناء في المجتمع، أو من زاوية المنهج الوظيفي أو منهج الصراع، فهي في جميع الحالات نتائج للاختلالات الاجتماعية داخل النظام.
وهذه الدراسة تركز على الحقائق الوصفية بما يقود إلى معرفة الأسباب والنتائج المترتبة على ظاهرة معينة حيث يتم التركيز على أربعة أبعاد:
أ) مسيرة الحركات الاجتماعية وتتضمن كيفية تطور ونمو هذه الحركات
ب) الصورة المؤسسية التي تأخذها
ج) الكيفية التي تصبح بها الحركات الاجتماعية جزءا من الحياة العامة للمجتمع، أي كيف تحظى بالمشروعية
د) الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الفترة الزمنية التي تظهر فيها الحركات ويتضمن ذلك أيضا العلاقة بين الحركات الاجتماعية والقوى السياسية الأخرى.
تعريفات الحركة الاجتماعية والسياسية**
طرح العديد من الباحثين تعريفات مختلفة للحركات الاجتماعية والسياسية، ولكن برغم اختلافها فإنها تجمع بين عدة عناصر رئيسية تميز هذه الحركات وسعى الباحثون إلى التفرقة بين الحركات وغيرها من المفاهيم مثل جماعات الضغط والمصالح والأحزاب والأهم من ذلك حرص بعضهم على تمييز الحركات الاجتماعية والسياسية عن غيرها من صور السلوك الجمعي. ففي المعنى الدقيق للحركات الاجتماعية والسياسية هي جهد جمعي ضعيف تنظيميا ولكنه يتسم بالإصرار على دعم هدف اجتماعي مؤداه إما تحقيق أو منع تغيير ما في بنية المجتمع ونظام القيم السائد.[4]ويعرفها هيربرت بلومر وهو أحد العلماء المهتمين بالسلوك الجمعي بأنها في التحليل الأخير تعد بمثابة سلوك جمعي يعبر عن عدم الكفاءة الاجتماعية أو القلق والاضطراب الاجتماعي في أثناء نموها، ومن ثم فإنها تتضمن كل مظاهر السلوك الجمعي.[5]ويعرفها د. رفعت سيد أحمد بأنها بمثابة جهد جماعي ومطلب مشترك بين جماعة من الناس يعملون معا، بوعي، وباستمرار على تغيير بعض أو كل أوجه النظام الاجتماعي والسياسي القائم، وأنهم يمرون بعدة مراحل لكي يصلوا إلى هذا الهدف، تبدأ عادة بحالة من القلق والتوتر الجماعي غير المنظم، لتنتهي بتكتيل صفوف ووعي القائمين بالحركة وتوجيههم نحو هدف واحد محدد وهو تغيير النظام الاجتماعي والسلطة السياسية القائمة.[6]
ويمكن استنتاج عدد من الركائز التي يستند إليها مفهوم الحركة الاجتماعية والسياسية وهي:
أ – حدوث مجموعة من الأفعال المتصلة والمستمرة لجماعة معينة من الناس.
ب – خلل اجتماعي في بناء القيم الثقافية والأوضاع الاجتماعية والنظام السياسي.
ج – توافر الوعي بعدم الرضا والسخط على الأوضاع القائمة، وبالأهداف المنشودة.
د – أن يستهدف هذا الجهد إحداث التغيير الاجتماعي.
ه – توافر الحد الأدنى من القدرة على إحداث التغيير، وذلك لأن السخط الذي يرجع إلى الفقر أو صراع القيم غير كاف وحده لتشكيل حركة وتوافر حد أدنى من التنظيم لتعبئة جهد الحركة وتحويله إلى نشاط ملموس.
وفيما يخص أسباب قيام الحركات الاجتماعية والسياسية فتشير الدراسات إلى أن هناك ثلاث مجموعات من العوامل تعد أسبابا لقيام الحركات، وقد تتوافر المجموعات الثلاث في قيام حركة ما أو تقتصر على نوع واحد منها وفقا لظروف كل حركة وهي كما يلي:
أ) العوامل النفسية والسيكولوجية: وتدور حول الأسباب التي تضعف ارتباط الشخص بجماعة تقليدية كالأسرة أو أي مؤسسة أخرى وتجعله يرغب في تحديها والمخاطرة بفقدان تأييدها ودعمها له لأنه أصبح يؤمن بقضية غير شائعة بين الناس، وتلك التي تشكل عناصر ترغيب له للارتباط بحركة ما.
ب) العوامل اجتماعية: ويقصد بها الشروط أو الظروف المحددة التي تؤدي فعلا إلى قيام الحركات الاجتماعية والسياسية، وليس الأسباب التي تشكل بوجه عام مناخا مواتيا لظهور الحركات. فمن الصحيح أن الأزمات الأقتصادية والسياسية، والفقر الواسع الانتشار والاختلالات الحادة في التركيب الطبقي للمجتمع تعد أسبابا قوية لحدوث حركات تطالب بالتغيير – ولكن من الممكن أن توجد جميع هذه الأسباب أو بعضها دون أن تنشأ الحركة فعلا، وذلك لأن هناك مجموعة من الشروط أو المتطلبات المنبثقة من هذه الأسباب الواجب توافرها، لأنها تمثل العوامل المباشرة أو المفجرة لقيام الحركة، ويمكن إجمالها في الآتي:
- اهتزاز القيم والمعايير، كأن تصبح القيم السائدة غير ملائمة للظروف الفعلية للحياة اجتماعية.
- القلق الاجتماعي، حيث يسبب انتشار بعض المشاعر مثل الشك واليأس حالة من القلق الاجتماعي، والذي يتولد نتيجة للاتصال بين الناس أو نتيجة الانتقال الاجتماعي السريع.
- الحرمان، والسخط والاحباط
- التحول في ميزان القوى داخل المجتمع. ويرجع ذلك إلى توزيع القوة يقف عائقا أمام أي فعل مؤثر من جانب أي جماعة تفكر في تشكيل حركة ما.
- التغييرات في نظام الاتصالات داخل المجتمع
ج) العوامل الخارجية
وفيما يخص الملامح العامة للحركات الاجتماعية والسياسية فيمكن رصدها كما يلي:
- الارتباط بالتغيير الاجتماعي
- البناء الفكري المتميز
- البناء التنظيمي الضعيف والتضامن الداخلي القوي
- الاستمرارية وسرعة الانتشار والتغلغل التلقائي
- عدم الاستقرار والتذبذب والتطور من وقت إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى
أسباب التطبيق وخصائص الحركات الاجتماعية والسياسية*
في البداسة سنركز على معرفة الدوافع والأسباب في تناول الحركات الإسلامية على أنها حركات اجتماعية وسياسية. والحقيقة أن هناك أسباب كثيرة تبرز هذه النظرة. ومن أصحاب هذا الرأي د. على الدين كتب "أن الحركات الإسلامية هي تأكيد أو إثبات الصور التقليدية للفهم والسلوك في بيئة تتغير جذريا، وأنها على عكس الآراء، تؤكد أن الأمور يمكن أو يجب أن تمضي كما كانت عليه في الأجيال السابقة، فإن الحركات الإسلامية تدرك أنها تتحدث إلى بيئة متغيرة ومناخ مختلف من التوقعات. وقد تكون هذه الحركات معارضا أعمى لكل التغيير الاجتماعي، ولكنها تصر على أن التغيير يجب أن يكون محكوما بالقيم وصور التفكير التقليدية: وهي رؤية تجد جاذبية لدى الشرائح المتعلمة من الناس الحريصين على استعادة مجد الإسلام، وإنها ليست "الديانة الشعبية" للأميين، بل وسيلة لتعبئتهم، كما أنها تجد جاذبيتها عند الجماعات التي اهتز دورها ونفوذها بسبب عملية التغيير الاجتماعي".[7]
ونظر د. سعد الدين ابراهيم النظرة نفسها، واستنتج من الملاحظة الميدانية أن الحركات الإسلامية تسعى إلى بناء نظام اجتماعي جديد قائم على الإسلام وتحدث في دراسات أخرى عن العوامل المؤثرة في صعود هذه الحركات مشيرا إلى مسائل مثل الهوية، والتحديث، والميراث الثقافي، والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة السياسية، والسيطرة الأجنبية ثقافيا وسياسيا.[8]
ومن جهة أخرى فإن تناول الحركات الإسلامية كحركات اجتماعية وسياسية يجنب الباحث مَزالق التعميم والأحكام المسبقة وأوجه الغموض التي اتسمت بها دراسات شتى صدرت عن ظاهرة الإحياء الإسلامي، كما أنه قد عكست بعض الدراسات الغربية نظرة تجزئيئة للإسلام وطرحت معان مختلفة للمفهوم الواحد، وركزت على مجموعة من المفاهيم ذات الدلالات السلبية، خاصة الربط بين الإسلام والعنف. هذا فضلا عن الترويج لمفهوم الأصولية الإسلامية الذي شاع وسبب جدلا واسعا.[9] ولكن دراسة الحركات الإسلامية كحركات اجتماعية وسياسية تركز على كونها قوى سياسية في المجتمع لها أهدافها وخصائصها المتميزة واستراتيجيتها وتتأثر بالظروف الاقتصادية واجتماعية والسياسية والفكرية السائدة، شأنها في ذلك شأن أية قوى سياسية أخرى. وما صفة "الإسلامية" في هذه الحالة سوى تعبير عن الإطار الفكري الذي تنطلق منه هذه الحركات فهي في حقيقة الأمر حركات اجتماعية وسياسية في مجتمعات إسلامية.
ومن جهة ثالثة، فإن إعادة اكتشاف الإسلام وتفسير أسباب انتشار الحركات الإسلامية يتحقق بصورة أكثر موضوعية بتحليل هذه الحركات الإسلامية كحركات اجتماعية وسياسية، لا بتناول ظاهرة الإحياء الإسلامي على إطلاقها، خاصة أن كثيرا من الدراسات الغربية أسقطت أحكامها العامة بالنسبة لظاهرة الإحياء الإسلامي على الحركات الإسلامية دون مراعاة للتباين بين الموضوعين وللتباين داخل الحركات الإسلامية ذاتها. ومن هذه الزاوية أصبح الباحثون مهتمين بإعادة النظر في نظرية الحداثة، وفي الأحكام القديمة الرافضة للحركات الدينية كحركات مهمة في التغيير الاجتماعي. والمعروف أنه إلى وقت ليس ببعيد انتهى كثير من الباحثين الغربيين إلى إخراج الإسلام كقوة فعلية من دائرة التطور السياسي والاجتماعي للمجتمعات الإسلامية والعربية وذلك بعد أن دخلت هذه المجتمعات مرحلة انتقالية إلى الحداثة. وقال هؤلاء إن انتقال هذه المجتمعات من الطبيعة التقليدية إلى الحداثة يعني سقوط الإسلام كإطار أو أيديولوجية مناسبة للتطور، أو على الأقل إنه سيصبح عاملا لا جدوى أو لا نفو منه لتطور هذه المجتمعات.[10]كما ركز فريق من الباحثين على تناول الإسلام من جوانبه الثقافية والعقيدية دون النظر إلى أنه قوة اجتماعية وسياسية. ولكن مع صعود موجة الإحياء الإسلامي منذ عام 1979 ظهر الإسلام كقوة للتغيير سواء على مستوى الأيديولوجية أو الممارسة السياسية، واعتبر أسلوبا للحياة الاجتماعية لكثير من المسلمين.[11] فأصبح مصدرا لحركات سياسية شتى بل مالت النظم السياسية في المجتمعات الإسلامية إلى إدراجه ضمن توجهاتها وأساليبها في إدارة البلاد.[12]
هذا وتطور في الخمسينيات فرع داخل الإطار العام لعلم الاجتماع يبحث بصورة علمية في الظاهرة الدينية بمعناها الواسع، وسمي هذا الفرع بعلم اجتماع الدين. ويسعى هذا العلم لا لتأمل الظاهرة الدينية في محتواها، وإنما لبحث طبيعتها ودورها اجتماعي والتغيرات التي تعتري هذه الطبيعة وهذا الدور في سياق التطور التاريخي. وبينما تهتم المعرفة العلمية بالظاهرة الدينية كنشاط إنساني فإنها تولي اهتماما خاصا بالجانب السياسي لهذا النشاط وما يترتب عليه من سمحها بإمكانية إخضاع الفكر الديني للتفكير السياسي والاجتماعي. ومن هنا مثلا يرتبط فكر ديني معين بنمط اجتماعي واقتصادي في فترة زمنية محددة ويتغير بتغيره. فمن هذه الخاصية تستمد الحركات الدينية خصائص أخرى تميزها عن غيرها وهي قدرة الدين على إعادة توجيه شخصية وسلوك الفرد جذريا، وادعاء الحركات الدينية أنها تحظي بأولوية على غيرها وسط الأيديولوجيات المختلفة بالنظر إلى كونها الوحدة التي تحتكر طرح الحقيقة الأيدولوجية سواء عن طريق الوحي أو العقل، حيث قدرة الدين على إحداث الاندماج والتضامن اجتماعي.[13]
ومن متابعة التطورات السياسية التي لحقت بالمجتمع الإسلامي منذ بداية عهد الخلفاء الراشدين وحتى الوقت الراهن، يمكن القول أن مظاهر التعبير عن الأهداف والمصالح لبعض الجماعات اتخذت شكل الحركات الاجتماعية والسياسية. فموجات الإصلاح وحالات الثورات التي عرفتها النظم السياسية الإسلامية ما هي إلا صور لنشاط حركات إسلامية مختلفة. وقد شهد تراث الإسلام ظهور جهود جماعية متنوعة تنشد التغيير، انطلقت بتلقائية في مجتمعاتها واتسمت بالانتشار والتغلغل، بعضها كان منظما والآخر أقل تنظيما أو منعدم التنظيم، سعت هذه الجهود جميعا إلى تحقيق أهداف معينة في التغيير الاجتماعي والسياسي. وكان لهذه الجهود الجماعية رموزها وقياداتها. فيمكن القول بأن بعضها كان ثوريا، والآخر إصلاحيا.
وكانت هذه الجهود هي شكل الاستجابة من جهة جماعات مختلفة لأزمتين حادتين واجهتا المجتمع والنظم الإسلامية منذ القدم، وهما الأزمة الروحية، أو الأزمة اجتماعية والسياسية، أو بمعنى آخر كيفية الحفاظ على العقيدة الدينية والجوانب الأخلاقية المرتبطة بها، وإقامة دولة إسلامية تنشد العدل والمساواة. ونشأت الأزمتان من تداخل أسباب ثلاثة دفعت جماعات مختلفة لطلب الإصلاح أو الثورة هي: اهتزاز العقيدة، والفساد والجور، والتهديدات الخارجية. وقد نتجت عن هذه الأسباب الثلاثة عوامل مباشرة قادت إلى ظهور حركات بعينها لها خصائصها المتميزة عن بعضها بعضا. ومن هذه العوامل اهتزاز القيم والمعايير، وانتشار حالات القلق الاجتماعي، ووقوع الحرمان والسخط والإحباط.
فمن ناحية أولى كان هدف التغيير الاجتماعي والسياسي قاسما مشتركا للحركات الإسلامية على مدى الزمن، حيث يشير تراثها الفكري إلى رفضها للأوضاع القائمة في المجتمعات والنظم الإسلامية باعتبارها أوضاع تخرج عن الإسلام الصحيح من وجهة نظرها، وتركز جهدها على إقامة الإسلام كنظام شامل للحياة الاجتماعية والسياسية للمسلمين. ومن ناحيلة ثانية فإن الحركات الإسلامية على خلاف طبيعة الحركات الاجتماعية والسياسية حظي معظمها ببناء تنظيمي قوي وليس ضعيفا. وربما يرجع ذلك إلى طابع السرية الذي اتسمت به الحركات الإسلامية عبر الزمن، ولقوة الاعتبارات الأيديولوجية والإصرار على تحقيق التغيير الاجتماعي الجذري ولبطش الحكومات الإسلامية بغالبية الحركات الإسلامية الرافضة.
و من ناحية ثالثة توفرت للحركات الإسلامية خاصية الانتشار والتغلغل التلقائي، وساعدتها في ذلك بوجه خاص طبيعة الدين الإسلامي ذاتها التي تفرض على المؤمن الحق أن يبادر بتطبيق تعاليم الإسلام دون توجيه، وقوة الشعور الروحي عند المسلمين مما يسهل تقبل الدعوات الإسلامية. وقد تحققت هذه الخاصية في الماضي والحاضر على حد سواء، فقد امتدت حركات الخوارج والشيعة ومثلا إلى خارج مواطنها الأصلية. ومن ناحية رابعة فجميع هذه الحركات تنطلق من تراث فكري إسلامي عريض ومتنوع، والاجتهادات في تفسير الإسلام كثيرة، فلم يعرف التاريخ الإسلامي زوال كامل لكل ما ظهر منذ عهد النبوة من تيارات إسلامية فكرية. وتعتبر الحركات الإسلامية استمرارها نجاحا في حد ذاته، حتى وإن لم تحقق أهدافها الفكرية، وذلك لاعتقادات بأنها تؤدي دورا ساميا أو رسالة مقدسة من أجل تطبيق الإسلام.
وإذا كان النجاح الحقيقي للحركة الاجتماعية والسياسية عموما يتمثل في قدرتها على تعميق الاقتناع لدى أعضائها بالمصلحة المشتركة من وراء التغيير الاجتماعي، فإن ذلك يتوفر بشكل أوضح في الحركات الإصلاحية والثورية والتي لا تخرج الحركات الإسلامية عموما عن أن تكون واحدة منها. والمقصود بالاقتناع هنا الشعور بأن مصلحة الجماعة أو الحركة تتفق مع القيم والمبادئ السامية أي حائزة لرضا الله، ومن ثم فأن نجاحها مقطوع به ولو بعد حين. والوجه الآخر لشعور الحركة الإسلامية بقدسية رسالتها هو اعتقادها في انحراف المعارضين لها عن الصواب. وتاريخ الحركات الإسلامية لا يخرج عن هذه الملاحظة فهي تربى أعضاءها على قوة الإيمان بصدق الرسالة التي يؤدونها، وبأن هناك مردودا إيجابيا سيعود على العضو من تطبيق أهدافها يتمثل في رضا الله قي الآخرة، وتطبيق تعاليم الإسلام باعتبارها واجبا لا يكتمل إسلام المسلم إلا به*. ونظرا لنجاح الحركات الإسلامية في هذا المجال فهي تستمر وتتجدد عبر الزمن.
محددات نشاط الحركات الإسلامية*
اختلفت نظرة الباحثين في تفسير نشاط الحركات الاجتماعية والسياسية باختلاف ما وضعوه من متغيرات تحكم موقف هذه الحركات، وحسب مجال اهتمام الحركة أي ما إذا كان محدودا أو واسعا، وباختلاف الاستراتيجية التي تتبعها الحركة، أي ما إذا كانت ذات طبيعة إصلاحية أم ثورية. وقد طرح تشارلز تيلي في كتابه "من التعبئة إلى الثورة" نموذجا عرض فيه لأهم المتغيرات التي تتحكم في "العمل الجماعي" من خلال وصفه للإستراتيجية التي تستخدمها الحركات اجتماعية لبلوغ أهدافها.[14]وبرغم أن تعريف مفهوم العمل الجماعي يتسم بالعمومية الشديدة حسبما أوضحه تيلي نفسه بأنه يعني عمل مشترك من أجل تحقيق أهداف مشتركة، إلا أن تيلي فضل هذا المفهوم على مفاهيم الاحتجاج أو التمرد أو الاضطراب، لأنه يرى أن استخدام هذه المفاهيم ينطوي على حكم مسبق بأن هذه الحركات تنوي الاتجاه إلى العنف.
ويرى تيلي أن هناك خمسة متغيرات كبرى تتحكم في العمل الجماعي هي المصلحة والتنظيم، والتعبئة، والفرصة، والعمل الجماعي نفسه. وفي المصلحة ركز تيلي على أوجه المكسب والخسارة الناجمة عن تفاعل حركة ما مع حركات أخرى. وفي التنظيم اهتم ببناء الحركة الذي يؤثر مباشرة على قدراتها العملية لتحقيق مصلحتها. وأما التعبئة فقد أشار إلى أنها العملية التي بمقتضاها تكتسب الحركة السيطرة على الموارد التي تحتاجها. وأوضح أن ما يعنيه في تحليله للفرص هو العلاقة بين الحركة والعالم المحيط بها، وأما العمل الجماعي فهو يتكون من عمل الأعضاء مجتمعين في اتجاه السعي نحو المصالح المشتركة كما أوضح أن العمل الجماعي ينتج من المزج بين المتغيرات الأربعة السابقة.[15]
وقام تيلي بتعريف هذه المتغيرات فأوضح أنه يقصد بالمصلحة إدراك أعضاء الحركة لما سيعود عليهم من نفع أو خسارة نتيجة تفاعلهم مع الجماعات الأخرى، وما يتطلعون إلى تحقيقه من وراء التغيير الاجتماعي. و يقصد بالنتظيم الهوية المشتركة والبناء الموحد بين أعضاء الحركة، وهو يمثل محصلة تعريف الأعضاء لأنفسهم، وتعريف الآخرين لهم باعتبارهم يشكلون مجموعة متميزة. وأما التعبئة فهي العملية التي بمقتضاها تنتقل الجماعة من كونها تحالف سلبي بين أفراد إلى المشاركة الإيجابية في الحياة العامة.
وفيما يتعلق بالجزء الثاني من النموذج، أوضح تيلي أن المقصود بالقمع - التسهيل هو عمل من جانب حركة أو جماعة أو حكومة أو قوة سياسية أخرى تزيد من تكلفة العمل الجماعي للحركة موضع التحليل. ويذكر أنه إذا كان الطرف الآخر المواجه للحركة هو الحكومة فأننا نطلق على القمع أو التسهيل وصف السياسة. وقد أشار تيلي إلى شكل آخر يقع بين القمع والتسهيل سماه بالتسامح. ويرى تيلي أنه كلما اتسع مجال عمل الحركة كلما كانت أكثر عرضة للقمع، كما أنه كلما زادتقوة الجماعة أصبحت أقل عرضة لاحتمال القمع. ويميز في إطار متغير القوة بين عنصرين مهمين هما الكفاءة والفعالية. [16]
وأخيرا يأتي متغير الفرصة-التهديد. ويقصد تيلي بالفرصة الوضع الذي يتاح أمام الحركة الاجتماعية وتستطيع استثماره بما يكسبها قوة إضافية. وهنا يشير تيلي إلى أن الفرصة تتعلق بالمطالب الجديدة للحركة والتي تهتم بتحقيقها وتكون حساسة تجاه التوصل إليها.
أولا: المحددات الداخلية
وتتضمن البناء الفكري، والبناء التنظيمي، والموارد. ويشتمل البناء الفكري على أربعة متغيرات هي: الأيديولوجية، ويقصد بها المقولات الفكرية، وتقوم الأيديولوجية بوظيفة تحديد الأهداف، وتحقيق التضامن الداخلي للحركة والتميز عن الآخرين. والمتغير الثاني هو مطلب التغيير الاجتماعي والسياسي. وقد يكون هذا التغيير محدودا أو شاملا. وفي حالة الحركات الإسلامية موضع البحث فإن التغيير الذي تتبناه يتسم بالشمولية. ولكنها في حقيقة الأمر لا توضح اتجاه التغيير الذي تطلبه، بمعنى أنها تكتفي بإطلاق مبدأ التغيير على مستوى المجتمع ونظام الحكم دون أن توضح نوعية السياسات لحل المشكلات التي تثيرها. والمتغير الثالث هو الرغبة في الانتشار والاستمرار، وغالبا ما أدى هذا الرغبة إلى مراجعة لأساليب النشاط من حين إلى آخر باتباع المراوغة، أو المهادنة أو الدفاع أو الهجوم حسب تقدير الحركة لقوتها في فترة زمنية معينة ولمصلحتها المشتركة. والمتغير الرابع هو الإستراتيجية التي تتبعها الجماعة لتحقيق الأهداف، ولا تخرج الحركات الإسلامية عن اتباع إحدى إستراتيجيتين: إما الإصلاح أو الثورة. ويتعين التوضيح في هذا الموضع أن الحركات الإسلامية عموما تهدف إلى إحداث تغيير جذري في بنية المجتمع والنظام السياسي بطرح بديل إسلامي لما هو قائم من قيم وأسس لنظام الحكم، ولكنها تختلف في كيفية تحقيق التغيير وحجمه حسب الزمن. فبعضها يؤمن بتحقيق التغيير على مراحل وبخطوات جزئية. ومن هنا برز وصف الإصلاح على توجهاتها. وبعضها يطالب بتحقيق التغيير الشامل فورا ودون انتظار حتى لو أدى ذلك إلى استخدام القوة ومن هنا تكتسب سمة الجذرية أو الثورية.
وأما من حيث البناء التنظيمي، فإن أول المتغيرات هو الهيكل النظمي الذي يتوقف شكله على طبيعة فكر الحركة وإستراتيجيتها، فكلما كانت الحركة أكثر رغبة في الاهتمام بجانب الدعوة الفكرية وتحقيق التغيير على مدى زمني أطول، كان بناؤها التنظيمي متسما بالمركزية الشديدة. وكلما كانت الحركة أكثر ميلا إلى الإسراع بالتغيير، اتسم بناؤها التنظيمي باللامركزية. وثاني هذه المتغيرات هو الدور المحوري للقيادات في الحركات الإسلامية. ففي الحركات الأكثر نشاطا والراغبة في التغيير السريع والجذري يكون الدور البارز للقيادات العملية وليس للقيادات الفكرية. ثم فالحركات التي تبغي إحراز النجاح السريع وتتبنى العنف تشهد ازديادا وتنوعا في القيادات لحاجتها الماسة لقيادات حركية بارزة تجمع التنظيم متسما بالحيوية والفاعلية. وأما الحركة التي تسعى لتحقيق أهدافها على مدى زمني أطول فإنها غالبا ما تتسم بقيادة مركزية وكاريزمية واحدة ولا تسمح بتنوع وتعدد القيادات.
ثانيا: المحددات الخارجية
وفيما يتعلق بالمحددات الخارجية فإنها تشمل: أولا: العلاقة مع السلطة الحاكمة. وتتضمن هذه العلاقة ثلاثة متغيرات هي التعاون والتهديد والتمرد ويتوقف أي منها على اعتبارين: الأول هو حجم الفرص التي تتيحها السلطة للحركات القائمة، والثاني هو مدى تهديد الحركات للسلطة الحاكمة أو تحدي الحركات لها مما يشمله من رفض الانصياغ لقوانينها ومباشرة ألوان مختلفة من النفوذ تشكل تهديدا للسلطة الحاكمة. وثانيها متغير العلاقة فيما بين الحركات الإسلامية ذاتها، وثالثها متغير العلاقة مع القوى السياسية الوطنية الأخرى وتتراوح هذه العلاقة في حالة الحركات الإسلامية بين من يعترف بدور هذه القوى، ومن يرفض التعامل معها ويتهمها بالكفر.
الحركات الإسلامية: النشأة والمدلول وملابسات الواقع
خلفية تاريخية - فكرية*
ليست قضايا التجديد والبعث الديني بالأمر الطارئ على التجربة الإسلامية، لا تاريخيا ولا فكريا؛ إذ تعتبر العقيدة الإسلامية البعث والتجديد والإحياء جزءا أصيلا من مسلماتها، بدءا باعتبار الإسلام نفسه بعثا للملة الحنيفية الإبراهيمية، وتجديدا لما اندرس منها بفعل الانحرافات التي اعترت الديانات السماوية، وانتهاءً بتأكيد النصوص الإسلامية المتكررة ضرورة حماية الدين من الاندثار والانحراف إذ تشمل مقومات الحماية العلم والتعلم، والذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، ومراجعة النفس، وكل ما من شأنه الحماية ضد الانحراف والنسيان، وتدارك ذلك متى ما وقع. إذن ظاهرة البعث والتجديد وما ارتبط بها من دعاوى ليست جديدة ولم تظهر في هذا العصر فقط.
وقد ظل تاريخ الإسلام حتى عهد قريب يشهد دعوات متكررة ينصِّب القائمون عليها أنفسهم مدافعين عن الدين ضد كل خطر وانحراف، مع إدانة المجتمع أو الدولة بالانحراف الذي يحتاج إلى تقويم وإصلاح. واستمر هذا الأمر حتى فجر الحداثة، حين ظلت أنحاء دار الإسلام تشهد هبات إصلاحية تهدف إلى إصلاح ما انهدم من شأن الدين وبعث ما اندثر من أمره. ومن هذه الحركات حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد (1703-1791) والحركة السنوسية في شمال إفريقيا (1859-1878) والمهدية في السودان (1881-1898) وحركة دان فوديو في نيجيريا (1754-1817) والدهلوية في الهند (1702-1762)، وغيرها في بقاع أخرى كثيرة من العالم الإسلامي. وقد سبقت هذه الحركات التي غلب عليها الطابع السياسي ولحقتها حركات أخرى كثيرة روحية واجتماعية، منها نشأة وانتشار الطرق الصوفية: الخلوتية والإدريسية والتجانية والسمانية والختمية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وعودة الروح إلى طرق صوفية قديمة شهدت انبعاثا وسعة انتشار، مثل النقشبندية والشاذلية والقادرية وغيرها.
ولكن كل هذه الحركات التي سبقت الحداثة تمتاز بأنها حركات جعلت الهم الديني أساس عملها ولب أهدافها. ويشمل ذلك حتى الحركات التي اتجذت منحى سياسيا مثل السنوسية والمهدية والوهابية. ولم يكن من بين هموم هذه الحركات لاضطلاع بإصلاح اقتصادي أوسياسي أو اجتماعي، إلا بقدر ما يكون مثل هذا الإصلاح من مطالب الدين وتطبيقا لقيمه أو تعاليمه. وهذا يعني أن المرجعية في الأمة الإسلامية كانت داخلية حتما، ودينية إلى حد كبير؛ إذ كانت تسعى حركات الإصلاح إلى إصلاح شأن الأمة الديني والدنيوي من منظور إسلامي بحت. غير أن هذه الخاصية بدأت تتأثر بعد مواجهة الأمة مع الحداثة، والتي كانت في مبدئها مواجهة عسكرية مع القوى الأوربية الصاعدة. وشهدت هذه الفترة تحول الأمة الإسلامية تدريجيا من القوة العظمى المستقلة بشؤونها والمهيمنة على محيطها إلى مجرد قوة بين القوى الكبرى، ممثلة في الدولة العثمانية وبدرجة أقل في مصر بقيادة محمد علي، وهي مكانة سرعان ما فقدتها بانهيار الدولة العثمانية ثم وقوع أغلبية الدول الإسلامية الأخرى تحت نير الاستعمار تباعا. كان الاستعمار تجربة جديدة تماما على الأمة الإسلامية التي واجهت قبل ذلك كثيرا من المحن والزرايا، بما في ذلك الاجتياح المغولي والصليبي وفقدان الأندلس والحروب والفتن والانهيار والتأكّل لنظامها المثالي. لكن آيّا من تلك الانتكاسات لم تزعزع ثقة الأمة بنفسها كما زعزعتها فترة الهيمنة الأوربية. فالمغول لم يقدموا نظرة بديلة للكون والحياة، ولم يكن لهم زاد سوى العنف الأعمى. أما الصليبيون فلم يقدموا شيئا جديدا غاب عن المسلمين، أو نظرة لم يكن أمرها محسوما في العقيدة الإسلامية، بينما لم يختلف نهجهم البربري كثيرا عن سابقيهم من المغول. ولهذا لم تواجه الأمة فتنة بسبب هذه المواجهات، ولم يكن يساورها شك في انتصارها الحتمي على الأعداء، وبالفعل جاء هذا النصر في الأغلب ساحقا وكاملا.
ولكن شيئا بدأ يتغير في القرون الثلاثة الأخيرة، وتغير معه وعي الأمة بنوعية التحديات التي أخذت تواجهها. وكان التركيز في بداسة الأمر على التحديات العسكرية، حيث اتجه النظر إلى تحديث الجيوش وتسليحها وإعادة تنظيمها. ودخل في هذا الباب التدريب، والتزود بالعلوم الحديثة في مجالات الهندسة والطب وغيرهما. وتطور الأمر إلى التوسع في دراسة العلوم وإرسال البعثات إلى الغرب، وأدى هذا بدوره إلى اطلاع أوسع على ما ظن البعض أنه خلفيات التفوق الأوربي، ومن هنا بدأ البعض يعبر عن آراء معادها أن الأمر لا يتعلق بالتفوق العسكري فقط. وما لبث الافتتان الأولي بالنموذج السياسي الغربي (رفاعة الطهطاوي 1801-1873) أن تحول إلى تأملات عميقة في أسرار نجاحه (خير الدين التونسي 1890)، ثم إلى تمثل أيديولوجياته في حركات فكرية وسياسية، بدءا بالحركة القومية في تركيا ومن ثم في العالم العربي، ثم الحركات الدستورية في إيران.
ولم يَطل العهد قبل أن يُطل عصر الثورات، بدءا بثورة أحمد عرابي في مصر عام 1882 ثم انقلاب حركة الاتحاد في تركيا عام 1908، ثم "الثورة العربية الكبرى" عام 1916، ثم تلك السلسلة اللامتناهية من الانقلابات والثورات التي ما زلنا نعيش ذيولها. وبدأ على المستوى الفكري أيضا تثور تساؤلات متعددة الأبعاد، كان من أبرزها وأعمقها تلك التي طرحها جمال الدين الأفغاني (1839-1897) الذي كان يرى أن ضمور الفكر الفلسفي في الساحة الإسلامية هو سبب تأخر الأمة العلمي. وطرح الأفغاني أيضا تساؤلات حول فهم الدين، والتي رددها بعض معاصريه وكثيرون بعده، وتركز معظمها حول ضرورة إعادة النظر في المفاهيم الدينية السائدة، والرجوع إلى أصل الإسلام الناصع كما عرفه السلف الصالح. وتضمنت هذه التساؤلات محاولات لاستيعاب الأفكار والمؤسسات الجديدة التي نالت إعجاب المفكرين المسلمين مثل الديموقراطية والبرلمان والمؤسسات الاقتصادية الحديثة وما إليها. والملاحظ هو أن الهم المركزي لكل هذه الحركات الفكرية والإصلاحية والثورات والانقلابات والاضطرابات كان تحديدا محنة المسلمين الدنيوية: تخلفهم وضعفهم وفقرهم وتراجعهم أمام الآخرين وإلخ.
ولعل أبرز ما ميز هذا العالم الجديد كان الوعي بوجود عوامل وأبعاد ورؤى أخرى غير تلك التي عرفها الأسلاف؛ إضافة إلى التأثر بهذه العوامل الجديدة، إن لم يكن التعاطف معها والتوق إلى أن يكون المسلمون جزءا فاعلا فيها. وهذا هو العالم الذي برزت فيه الحركات الإسلامية الحديثة وبدأت تأخذ شكلها في إطاره.
الحركات الإسلامية: النشأة*
يمكن – أذا عدنا إلى نقاشنا الأول حول تعريف الحركات الإسلامية الحديثة – أن نقول إن أبرز السمات المميزة لهذه الحركات هي حداثتها. فهي حركات نشأت في كنف الحداثة واستجابا لتحدياتها. وهي أيضا إسلامية بمعنى أنها اختارت استجابةً لتحديات الحداثة المرجعية الإسلامية، ولا تنطلق مثل غيرها من منطق الفعالية المجردة، ولا تستند إلى قيم وأيديولوجيات أخرى تتعارض مع هذه المرجعية، أو تعتمد مرجعية من خارجها. كانت هذه الحركات إذن – وإلى حد كبير – وليدة هذا العالم الجديد الذي يعتبر الخروج عن الإطار الإسلامي التقليدي، وبمعنى آخر ثنائية "الحداثة-العلمنة" إحدى أبرز مزاياه. وكان لا بد لهذه الحركات من أن تحمل ملامح هذا العالم الجديد، وتتشكل بشكله إلى حد كبير. ويكاد يكون هناك ما يثبته الإجماع بين المحللين في هذا المجال في نسبة الحركات الإسلامية المعاصرة إلى الجهد الفكري والإصلاحي الذي بذله جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده (1849-1905) وبدوره تلميذه هو الشيخ محمد رشيد رضا (1865-1935)، حيث أبرزا السمات التي ستميز الحركات الإسلامية فيما بعد، وبخاصة تأثرها بالحداثة مع رفضها لها في آن معا.
وقد أثر الأفغاني مباشرة بفكره في جيل كامل من المسلمين حيث كان له تأثير أوسع غبر مجلة "العروة الوثقى" التي أصدرها وتلميذه محمد عبده في باريس عام 1884. ورغم أن الرجلين أعلنا في المجلة عن إنشاء تنظيم إسلامي عالمي بالاسم نفسه وهو "العروة الوثقى" فإن يبدو أن ذلك التنظيم كان أمنية أكثر منه واقعا. وانتشر هذا التأثير عبر محمد رشيد رضا ومجلته "المنار". ولا شك في أن الجو العام الذي خلقته هذه المدرسة الفكرية، وهمومها ومبادئها الأساسية: مقاومة الاستعمار، واستعادة مجد الأمة، وإرساء أسس الشورى وإصلاح الحكم، والإصلاح الديني وتجديد الدين، شكلت كلها الأسس التي قامت عليها الحركات الإسلامية الحديثة.
وقد حرص الأفغاني على تمييز موقفه الفكري والسياسي عن التيارات الفكرية والسياسية الأخرى، وبخاصة تلك التي سعت إلى مهادنة الغرب وقبول هيمنته السياسية، أو تلك التي سعت إلى التخلي عن بعض التعاليم الإسلامية أو تطويعها ل"ملاءمة" الحداثة. فقد شن هجوما عنيفا على مدرسة "الحداثة" التي روج لها المصلّح الهندي أحمد خان، وانتقد سياسة مصر في ممالأة الانجليز وهاجم شاه إيران نصر الدين لتقديمه تنازلات للشركات البريطانية، بل حرض على قتله. ودعا كذلك إلى التمسك بالدين وإحيائه بالعودة إلى أصوله ومنابعه النقية. وتعتبر هذه المبادئ والتوجهات التي سار عليها من بعده تلاميذه عبده ورضا من أبرز الملامح التي ميزت فكر الحركات الإسلامية الحديثة وتوجهها. وقد أكد نظرية الاستمرارية هذه الفهم الذاتي لقادة الحركة الإسلامية أنفسهم فالإمام حسن البنا كان على صلة بالشيخ محمد رشيد رضا ولم يخف تأثره به.[17] ولكن هذه الدلائل على استمرارية يجب ألا تجعلنا نغفل عوامل الجدة والمفارقة في الحركة التي أنشأها حسن البنا في الإسماعيلية عام 1928. فقد نشأت تلك الحركة ومحمد رشيد رضا حي يرزق، وكانت العوامل التي أدت إلى إنشائها عوامل مباشرة، انطلقت من رؤية معينة للأزمة، وشعور بأن المؤسسات الإسلامية القائمة، بما فيها مجلة المنار ومدرستها، لم تعد قادرة على التصدي لهذه الأزمة. فقد انفعل البنا – كما ذكر – بما رآه في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى في مصر من تيار جارف لتأثير الغرب الفكري والثقافي والسلوكي والأخلاقي، ودفعه الشعور بالخطر إلى التحرك لاستنفار العلماء ورجال المؤسسة الدينية بهدف التصدي لتيار الفساد والانحلال هذا. إلا أن ردة فعلهم كانت مخيبة للآمال، مما دفعه إلى أن يتخذ مبادرات شخصية وفردية لمواجهة المشكلة، كان أبرزها ممارسة الوعظ الديني في المقاهي والطرقات العامة. وفي الإسماعيلية سرعان ما واجهته إشكالية نتجت عن هذا السلوك، وهي ماذا يفعل بمن يستجيبون لدعوته؟ وقد جاءت الإجابة أيضا عفوية، بدءا من الاستجابة لطلب بعض العمال هناك أن يساعدهم على تعلم شؤون الدين وممارسة الشعائر.[18] وهكذا بدأت تلك النواة الصغيرة وكبرت من هموم تعليم الصلاة والوضوء واتخاذ مسجد، إلى التصدي لقضايا أوسع، ثم إلى التوسع في العضوية وإنشاء الفروع حتى عمت كل البلاد، وبلغت العضوية عشرات، بل مئات الآلاف.
لقد كانت المؤثرات المحلية والظرفية نفسها هي العامل الحاسم في نشأة الجماعة الإسلامية في الهند على يد أبي الأعلى المودودي عام 1941. وقد بدأت مساهمة المودودي تقليدية، حيث تصدى للدفاع عن الإسلام ضد شبهات منتقصيه من الهندوس. ولكنه سرعان ما اتجه بالنقد إلى توجهات قيادات العمل الإسلامي في الهند، بداية بانتقاد دعوة المؤتمر القومي الهتدي إلى دولة علمانية استمرارية توحد بين المسلمين والهندوس، مؤكدا أن هذه الدولة لن تكون علمانية حقيقية، لأنها ستميل إلى الأغلبية الهندوسية، وهي على كل مرفوضة لأنها تلزم المسلمين بخدمة الدولة القومية ومبادئها لا الإسلام وعقيدته.[19] ومن هنا يكون المودودي متفقا مع الدعوة التي أطلقها محمد إقبال وحملتها فيما بعد الرابطة الإسلامية، وهي إقامة وطن قومي منفصل للمسلمين. ولكن المودودي أدخر نقده الأشد لهذه الحركة القومية. حسب رؤيته فإن دعوة الرابطة الإسلامية لإنشاء وطن قومي للمسلمين في الهند تناقض تعاليم الإسلام، ولا يمكن أن تفضي إلى إقامة دولة الإسلامية على المدى الطويل، كما يزعم أنصارها. والسبب هو أن الدعوة القومية تناقض الدعوة الإسلامية تناقضا جوهريا، ولا يمكن أن يكون انتهاجها خطوة نحو الإسلام، بل هي هرولة في الاتجاه المعاكس؛ فمبادئ الجامعة القومية تقوم على التجمع من أجل مصالح فئة محددة، تستأثر بخيرات الدنيا دون غيرها، بينما دولة الإسلام هي دولة الفكرة، وجامعته هي جامعة العقيدة.[20] ويتمثل الحل عند المودودي في أن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها، وأن النهج الذي اتبعه النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان نهج بناء الأمة أولا، ثم الدولة ثانيا. والطريق إلى هذا يتم عبر نواة طليعية من المؤمنين بالدعوة الإسلامية، تتولى جمع الناس حولها والثبات على أصولها إلى أن تنتصر الفكرة، وتثبت الجماعة بانتصارها على المحن جدارتها بحمل الراية. ومع انتصار الأمة على المصاعب والأعداء، تولد الجماعة ودولتها التي تكون الحاكمية فيها لله وحده عبر انتقال الشريعة.[21] ويسمي المودودي النموذج السياسي لهذه الدولة "الدمقراطية الإلهية" (theo-democracy)[22]، إشارة إلى أن الحكم فيها شورى بين الناس، ولكن المرجعية النهائية فيها هي حكم الله وشريعة الإسلام.
لقد توسعت الحركتان اللتان أنشأهما البنا والمودودي وانتشرتا وأصبح لهما شأن في بلاد المنشأ وخارجها. فأصبحت حركة الإخوان المسلمين من أقوى الحركات السياسية في مصر، إن لم تكن أقواها على الإطلاق. أما الجماعة الإسلامية في الهند فقد كسبت أيضا سندا شعبيا، وإن كانت اتخذت نهجا صفويا (نخبويا) يخالف إلى حد ما النهج الجماهيري لحركة الإخوان المسلمين. وقد وصل تأثير فكر المودودي إلى قلب حركة الإخوان المسلمين وعبرها إلى العالم العربي عن طريق كتابات سيد قطب الذي استقى جزءا مهما من أفكاره من المودودي، وبخاصة مفهوم جاهلية المجتمع ودور الصفوة في إرساء أسس المجتمع الإسلامي.
تعددت الاجتهادات في أسباب الانتشار الواسع الذي لقيته هذه الحركات في المجتمعات الإسلامية، وبخاصة بعد ما عرف ب"الصحوة الإسلامية" في السبعينيات والثمانينيات. وقد رأى بعض المحللين في هذا النجاح ثمار الطفرة النفطية وآثارها[23] مقرونا بالشعور بالخيبة من فشل الحكومات والأيديولوجيات العلمانية، إضافة إلى أزمة الهوية والشعور بالدونية تجاه الغرب[24]. وعلل آخرون هذا التطور بالرجوع إلى أزمات أخرى، بدءا من الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929، ومرورا بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي ضربت العالم الإسلامي في النصف الثاني من هذا القرن.[25] وقد واكب هذه الأزمات حدة الصراع الطبقي وعجز المعارضة العلمانية وإفلاسها. ويضيف غيرهم الرأي بأن هذه الحركات هي رد فعل دفاعي في المجتمعات الإسلامية التي دهمتها الحداثة وهددتها بالتفكك والانهيار.[26] وثمة تفسيرات مماثلة ترجع صعود الحركات الإسلامية إلى طبيعة الدين الإسلامي نفسه، وعدم قابليته للعقلنة والعلمنة. ويضيف بعض هؤلاء أن الحداثة عززت مركز الإسلام النصي (مقابل الشعبي) بدلا من أن تؤدي إلى انحدار نفوذه كما حدث للمسيحية.[27] ومن التحليلات التي تسير في هذا الخط تلك المقولات التي تُرجع صعود الأصولية إلى فشل المفاهيم التقليدية، إضافة إلى بدائلها الحداثية (محمد عبده وعلي عبد الرازق وطه حسين..إلخ)، في كسب الجماهير.[28]
تنتهج التفسيرات الغالبة في تحليلها وتشخيصها للظاهرة الإسلامية إذن، منهج التفسيرالاجتماعي للعلمانية، ولكن بالمقلوب. فيرى البعض أن هذا النهج التشخيصي الذي يستصحب فرض العلمنة ضمنا هو نهج مغلوط من أساسه، لكونه يتناول القضية بالمقلوب، فالسؤال الذي يجب أن يطرح هو ليس: لماذا نشأت الحركات الداعية للتمسك بالإسلام وازدهرت؟ وأنما هو: لماذا فشلت الجهود والضغوط الرامية إلى خلخلة التمسك بالمبادئ الإسلامية في المجتمعات المعنية؟ والإجابة هي أن أولئك الذين أرادوا تقديم بدائل للإسلام لم يقدموا للمسلمين حججا مقنعة تصدهم عن دينهم ولا إغراء فاتنا يصرفهم عنه ابتغاء منفعة عاجلة.
وينتقد آخرون هذه الآراء التي تزعم بأن العودة إلى الإسلام هي عودة إلى ما هو طبيعي، حيث يقولون أن كون قيادات الحركات الإسلامية في أغلبها من القطاع الحديث المتأثر بالغرب وليست من العلماء والمشائخ، وكون أتباعها ما يزالون أقلية، إضافة إلى انتهاج تلك الحركات العنف لتمرير برامجها يؤكد أن ما أتت به هو بدعة جديدة وليس اتجاها طبيعيا أو أصيلا في المجتمع كما تدعي.[29]
يرى محللون آخرون أن إشكال الحركات الإسلامية ينعكس في إخفاقها عن تحقيق أهدافها، وهو إشكال يشير بدوره إلى خلل بيِّن في فكر هذه الحركات وأيديولوجيايتها وبنيتها التنظيمية. وفي المرات القليلة التي اقتربت فيها جهات إسلامية من السلطة إما مباشرة وإما بتحالف مع قوى أخرى، كما كانت الحال في إيران وأفغانستان والسودان واليمن وماليزيا والكويت والجزائر، فإن حاصل هذا الاقتراب كان تعميق الأزمة في تلك البلدان لا تجاوزها... الخ.
يتمثل الإشكال في هذه التحليلات في أنها تخلط خلطا كبيرا بين إدانة فكر الحركات الإسلامية وممارستها وبين الحكم بأنها فشلت وآلت إلى الاندثار؛ إذ ظلت الأحكام باندثار الحركات الإسلامية تصدر بانتظام منذ الأربعينيات من القرن الماضي. حقيقة الأمر أن فشل كثير من الحركات الإسلامية في تحقيق برامجها هو في الواقع تعبير آخر عن نجاحها. ففي مصر والجزائر وكثير من الدول الإسلامية، نجد أن فكر الحركات الإسلامية صار هو المهيمن اجتماعيا إلى درجة أن الأحداث أخذت تتجاوزها. فقد أصبح لبس "الزي الإسلامي" مثلا والتزام الشعائر الدينية ظاهرة جماهيرية تتجاوز بمدى بعيد عضوية الحركة الإسلامية ودائرة تأثيرها المباشر. بل إن جماعات إسلامية عديدة نشأت وأخذت تزايد على الحركات الإسلامية المعروفة وتتهمها بالتهاون في أمر الإسلام. إذن ما زالت الحركات الإسلامية من أكثر القوى الفاعلة على الساحة السياسية.
خريطة تصنيف الحركات الإسلامية
وفقا لمحورية الأساس الفكرية السابق توضيحها، فإن الحركات الإسلامية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين لا يجمع بينهما سوى الانتساب إلى الإسلام مع الاختلاف العميق قبل ذلك وبعده في طريقة هذا الانتساب وقراءة ذلك الإسلام. إنه يمكن القول أن نظائر لتلك الحركات المتنوعة قد سبق لها الظهور والتواجد خلال القرون الخمسة عشر التي تمثل التاريخ الإسلامي، وأن بعضا من الحركات التي نشهدها حاليا ليست سوى "إعادة انتاج" لتلك الحركات القديمة. كذلك فمن الضروري التأكيد على أن خريطة الحركات الإسلامية المقترحة هنا لا تشمل سوى تلك التي ترتبط بعلاقة ما مع السياسة وفي مركزها السلطة والدولة أكثر من ارتباطها بالمجتمع والممارسات الاجتماعية والدينية الطقوسية.
الحركات الإسلامية الدينية*
وهي تلك التي تقوم على قراءة معينة للإسلام والنصوص القرآنية الكريمة تنظر من خلالها للأفراد والمجتمعات والدول من منظور صحة العقيدة فقط، في حين لا تلقى اهتماما يذكر إلى ما هو دون ذلك من مستوايات ومصادر فقهية وشرعية. والقضية الرئيسية وربما الوحيدة بالنسبة لتلك الحركات هي إقامة التوحيد والعبودية الحقة لله كما تراهما، وبالتالي فإن حقيقة الإيمان بالنسبة للأفراد والمجتمعات والدول يظل بالنسبة لها المبحث الوحيد الذي تتحرك ضمنه أفكار وأفعال تلك الفئة من الجماعات. بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم بتفسير تلك النصوص القرآنية والنبوية بطريقة حرفية ظاهرية، وتدفع تلك المنهجية ذلك الحركات بصفة عامة إلى التورط في أحكام متسرعة بكفر الدول وجاهلية المجتمعات والأفراد. وفضلا عن تلبس تلك الحركات في أسمائها ومصطلحاتها وتشكيلاتها التنظيمية وسلوك أعضائها للموروث الإسلامي من حقبة النبوة والخلافة الراشدة التي تمثل المرجعية التاريخية الوحيدة لها، فهي تقوم بقراءة واقع مجتمعاتها المعاصرة عبر تجربة تلك الحقبة وتعيد تسمية فاعليه وقواه وتناقضاته بنفس المسميات التي كانت فيها. وبذلك فإن الهدف الرئيسي لتلك الحركات هو إعادة أسلمة المجتمعات والدول – وكذلك الأفراد بالنسبة للبعض منها – حيث أنهم جميعا حسب رؤيتها خارجون عن الإسلام بصور مختلفة. وتنقسم تلك الحركات الإسلامية الدينية في تبينها للحقبة النبوية وما تلاها من الخلافة الراشدة وقياس المرحلة الحالية عليها إلى قسمين رئيسيين:
1- الحركات المتطرفة السلمية
تتفق تلك الحركات على أن المجتمعات المعاصرة أقرب لحالة المجتمع الجاهلي والكافر في مكة بعد البعثة النبوية وقبل الهجرة منها إلى المدينة، كذلك فبنفس القياس فتلك الحركات ترى أن الوقت لم يحن بعد للعمل بالسياسة أو بناء دولة إسلامية[30] أو ممارسة القتال – أو الجهاد حسب مصطلحهم – حيث أن كل ذلك لم يؤمن به المسلمون قليلي العدد والحيلة في مكة. نتيجة لهذا، تذهب تلك الحركات إلى عدم ممارسة أي أفعال عنيفة أو قتالية ضد المجتمعات والدول والأفراد الكافرين أو الجاهليين حسب رؤيتهم لهم مثلما لم يفعل ذلك المسلمون الأوائل في المرحلة المكية. أما عندما يطرح التساؤل بداخل تلك الحركات حول طريقة التعامل مع هؤلاء الأفراد والدول والمجتمعات، فإنهم ينقسمون بناءً على إجابته إلى قسمين رئيسيين:
أ) حركات التكفير والهجرة
إنها ترى أن المجتمعات المعاصرة تشبه مجتمع مكة قبل الهجرة مباشرة، حيث لم يعد فيها من أمل أن تهتدي للإسلام ولم تعد تضم سوى الكافرين فقط وبالتالي لابد لهم من هجرها بصورة أو بأخرى، حيث أنهم يمثلون المسلمين الوحيدين على وجه الأرض ومن سواهم ولم ينضم إليهم فهو كافر كفرا بواحا. والهجرة بالنسبة لهم، سواء كانت داخل المجتمع باعتزاله تماما والانفصال عنه كلية أو بالخروج منه إلى الصحارى والمناطق البعيدة، إنما هي على غرار الهجرة النبوية انتظارا لأن يظهر الله دينه ويعودوا إلى ذلك المجتمع منتصرين.
ب) حركات إعادة الدعوة
حيث أن دعوة – أو بعبارة أدق إعادة دعوة – الناس الموجودين فيها والذين يجهلون الإسلام كما كان الكافرون في مكة يجهلونه، تعد المهمة الوحيدة التي يجب عليهم القيام بها كما فعل المسلمون الأوائل. ويمثل "التبليغ والدعوة" تعاليم الإسلام الأساسية وأركانه وعباداته من دون تبين اساليب العنف.
2- الحركات الجهادية العنيفة
تتفق الحركات الجهادية العنيفة على أن المرحلة التي يعيشها العالم اليوم يمكن مقارنتها بمرحلة هجرة الإسلام إلى المدينة وما تلاها. وهي تلك التي اندمجت فيها العقيدة والدين بالدولة، أي بالسياسة. وتتفق تلك الحركات ايضا على أن الحكومات في البلدان المسلمة قد خرجت عن الإسلام وتعد مسئولة عن حالة الجاهلية التي تعيشها نجتمعات تلك البلدان وعن نحاربة قوى التوحيد، التي ترى تلك الحركات أنها تمثلها. ونتيجة لهذه القراءة فإن المجتمعات الجاهلية المعاصرة حسب تلك الحركات لا تجوز إعادة دعوتها إلى أساسيات الإسلام بعد أن وصل إليها البلاغ واكتملت الرسالة، وبالتالي فلا مكان للدعوة المكية الهادئة المتنامية بل هو "الاستعلاء" المدني وإعادة أسلمة المجتمع والدولة وتأسيسهما من جديد على نفس القواعد التي أسست عليها دولة المدينة. ويعد العنف الديني، أو الجهاد كما أسمته تلك الحركات، هو الوسيلة الوحيدة تقريبا لديها من أجل تحقيق تلك الأهداف. ونتيجة اختلاف ظروف ومراحل ومناطق نشأة تلك الحركات الجهادية العنيفة، فإنها توزعت بين أقسام ثلاثة على الأقل تتفق فيما بينها حول المفاهيم الأساسية السابقة ثم تختلف بعد ذلك في الأولويات الحركية لتطبيقها.
أ) الحركات محلية الطابع
تنطلق الحركات محلية الطابع، والتي لا توجد تقريبا سوى في بلدان العالم الإسلامي، من فكرة أن "العدو القريب أولى بالقتال من العدو البعيد"، وهو بالنسبة لها حكومات الدول التي تنتمي إليها والتي يعد إسقاطها عبر قتالها هو المهمة الأولى التي ينشدها العضو. وعلى الرغم من أن الجهاد هو فرض على المسلمين للدفاع من أي هجوم عليهم من عدو خارجي، فقد حورته تلك الفئة من الحركات الجهادية ليصير جهادا داخليا. ولا شك أن وضع تلك الفئة من الحركات مفهوم "الجهاد" عنوانا لقتالها الداخلي ضد حكوماتها إنما كان يعكس من ناحية رؤيتها لها باعتبارها حكومات "كافرة" معادية للإسلام. وقد كانت "الجماعة الإسلامية" و"جماعة الجهاد" في مصر، و"الجماعة الإسلامية المسلحة" في الجزائر و"الجماعة الإسلامية المقاتلة" في ليبيا الآن أمثلة بارزة لتلك الفئة من الحركات الجهادية محلية الطابع.
ب) الحركات الاستقلالية-الانفصالية
إنها متواجدة بصفة عامة في مناطق الأقليات المسلمة بداخل الدول غير الإسلامية، وأبرزها تلك التي توجد الآن في قشمير بالهند والشيشان بروسيا الاتحادية وفي أفغانستان أثناء الغزو السوفيتي لها. ويتداخل لدى تلك الحركات مفاهيم الجهاد ضد العدو الخارجي غير المسلم مع مفاهيم التحرر الوطني وتقرير المصير. بالإضافة لذلك تحتفظ تلك الحركات بالأساس الفكري لكل الحركات الخهادية والمتمثلة في اعتبارها أن مجتمعات أقاليمها تعيش في حالة الجاهلية وأن هدفها الأول بعد تحقيق استقلالها أو انفصالها هو إعادة أسلمتها وإقامة الدولة الإسلامية فيها.
ج) الحركات دولية المجال
إنها على اشتراك مع الفئتين الأخيريين في الأفكار الرئيسية لتلك الحركات لكنها تتميز عنها بتفسيرات أخرى خاصة لها هي مفهوم الجهاد وأولوية القتال "للعدو القريب أم للعدو البعيد" تحديدا. فتلك الفئة تتبنى مفهوم الجهاد الخارجي ضد من ترى أنهم أعداء الإسلام الخارجيين فتعتبر أن "العدو البعيد أولى بالقتال من العدو القريب"، بالرغم من اتفاقها مع الفئات الأخرى في النظر إلى "العدو القريب"، أي حكومات الدول الإسلامية، باعتبارها حكومات كافرة.
الحركات السياسية – الاجتماعية ذات البرنامج الإسلامي*
تتبنى تلك الحركات برامج سياسية – اجتماعية تقوم أساسا على مفهوم "الشريعة" التي هي في حقيقتها إنتاج بشري – وليس نص ديني مقدس – قام به مئات الفقهاء المسلمين متبايني المذاهب والاتجاهات والأماكن خلال قرون الإسلام الخمسة عشر لتحويل النصوص القرآنية والنبوية الكريمة إلى قواعد قانونية واجتماعية وسياسية لتنظيم الدول والمجتمعات المسلمة. ولا تتوقف المرجعية التاريخية لتلك الحركات عند المرحلة النبوية والخلافة الراشدة، بل تتسع لتشمل التاريخ الإسلامي وتراثه الموزع على قرونه مستعينة أحيانا على قراءته بمرجعيات أخرى من أمم أخرى خارجه. ويظل الإسلام بالنسبة لتلك الحركات بمثابة وعاء حضاري – ديني – تاريخي تستمد منه رؤاها لتنظيم المجتمعات والدول الإسلامية التي توجد فيها والتي تتخذ شكل البرنامج الذي لا يختلف سوى في المضمون عن برامج الجماعات السياسية – الاجتماعية الأخرى غير الإسلامية. إنها تنقسم بدورها إلى نوعين:
1) الحركات السلمية الساعية للحكم
هي تسعى بصورة مباشرة إلى السلطة السياسية من أجل تطبيق برنامجها السياسي والاجتماعي ذي الطابع الإسلامي الذي تعتقد أن غايته هي تحقيق التقدم والنمو لبلدانها ومجتمعاتها. ومن أجل وصولها لذلك الهدف تسلك تلك الحركات كافة السبل والوسائل السياسية السلمية المباشرة وغير المباشرة المتاحة أمامها، وتقوم بتغيير وتنويع مواقفها وتحالفاتها وصراعاتها مع الدولة أو القوى السياسية والاجتماعية الأخرى بحسب ما تقتضيه مصلحتها وتحقيق ذلك الهدف. وتعد جماعة الإخوان المسلمين في مصر والبلدان العربية الأخرى التي توجد بها فروعها، وجماعة النهضة في تونس، والجبهة الإسلامية للإنفاذ في الجزائر أبرز تلك الحركات السياسية – الاجتماعية السلمية الساعية للحكم.
2) حركات التحرر الوطني المسلحة
دفعت بها الظروف المحيطة بها في مجتمعاتها التي تخضع لاحتلال أجنبي إلى تبني برنامج للتحرر الوطني يقع الكفاح المسلح في القلب منه. وقد بدأ ظهور تلك الحركات من بين صفوف جماعة الإخوان المسلمين إبان حرب فلسطين عام 1948 ثم المقاومة الوطنية المصرية ضد قوات الاحتلال البريطاني في مدن قناة السويس بدءا من عام 1951 وفي الوقت الحالي، فإن كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وحزب الله اللبناني تعد الأكثر بروزا وتمثيلا لتلك النوعية من الحركات.
*مراجع الاستناد:
1) عبدالوهاب الأفندي، وآخرون، الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2002)، صص 13-49
2) د.علا عبد العزيز أبوزيد (محرر)، الحركات الإسلامية في آسيا (جامعة القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية، 1998)، صص3-30
3) ضياء رشوان (رئيس التحرير)، دليل الحركات الإسلامية في العالم (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بأهرام، 2006)، صص 6-24
[1] عبدالوهاب الأفندي، مرجع سابق، ص8
** أو تصنيفات عديدة أخرى من الباب: السلفية والأصولية والمتشددية والإرهابية والمتطرفية والنعتدلية والإسلاموية... إلخ
[2] د.علا عبد العزيز أبوزيد، مرخع سابق، صص3-5
[3]عبدالوهاب الأفندي، ورجع سابق، ص14
*د.علا عبد العزيز أبوزيد (محرر)، مرجع سابق، ص3
** د.علا عبد العزيز أبوزيد (محرر)، مرجع سابق، صص4 -5
[4] The Shorter Oxford English Dictionary 3rd ed. (London: Oxford University Press, 1955), p.1292; The New Encyclopedia Britannica, vol 10, p.922
[5] Richard T.Schaefer, Sociology, (New York: McGraw – Hill Book Company, 1983) p.520
[6] نقلا عن رفعت سيد أحمد، ظاهرة الإحياء الإسلامي في السبعينات: دراسة مقارنة لمصر وإيران، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
*د.علا عبد العزيز أبوزيد (محرر)، مرجع سابق، صص 14-21
[7] Ali E.Hillal Dessouki. The Resurgence of Islamic Organizations in Egypt: An Interpretation, in: Alexander S.Cudsi and Ali E.Hillal Dessouki (ed.), Islam and Power (London: Croom&Helm, 1981), p.108
[8] Saad Eddin Ibrahim, Islamic Militancy as a Social Movement: the Case of Two Groups in Egypt, in: Ali E.Hillal Dessouki (ed.) Islamic Resurgence in the Arab World (USA, Praeger 1982) and Saad Eddin Ibrahim, Egypt’s Islamic Activism in the 1980s, in: Third World Quarterly, vol 10, No.2 (April 1988), p.32
[9] انظر دراسة نقدية للدراسات الغربية حول ظاهرة الإحياء الإسلامي أعدها حسنين توفيق إبراهيم، وأماني مسعود الحديني بعنوان "ظاهرة الإحياء الإسلامي في الدراسات الغربية: رؤية تحليلية نقدية، مجلة منبر الحوار، العدد 25 صيف 1992، بيروت، صص6-38.
[10] Ali E.Hillal Dessouki (ed.), Islamic Resurgence in the Arab World, p.3
[11] Shireen T.Hunter. (ed.) The Politics of Islamic Revivalism (Indiana: Indiana University Press, 1988), p.7
[12]جيل كيبيل، يوم الله، الحركات الأصولية في الأديان الثلاثة، ترجمة نصير مروة (قبرص: دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث، 1992)، صص 12-13
[13]محمد السيد سعيد، "مقمدة لتشخيص الحركات الدينية والسياسية"، في المجلة الاجتماعية القومية، المجلد 23، عدد يناير مايو – سبتمبر 1986، صص30 و36
*بالمعروف والنهي عن المنكرالمقصود هنا الأمر
*د.علا عبد العزيز أبوزيد (محرر)، مرجع سابق،صص 21-27
[14] Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (Massachussetts: Adison-Wesley Publishing Company, 1978), p.84
[15] Charles Tilly, op.cit., p.7-8
[16]Charles Tilly, op.cit., p.115-98
*عبدالوهاب الأفندي، وآخرون، مرجع سابق،صص15-19
*عبدالوهاب الأفندي، وآخرون، مرجع سابق،صص19-31
[17]الإمام الشهيد حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية (القاهرة: المكتب الإسلامي، 1983)، صص253-254
[18]المرجع السابق، صص 72-76
[19] See Charles J.Adams, “Maududi and the Islamic State”, in John Esposito (ed.) Voices of Resurgent Islam (Oxford: Oxford University Press, 1983), p 100-104
[20]أبو الأعلى المودودي، منهاج الانقلاب الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة 1979). انظر أيضا: أبو الأعلى المودودي: الإسلام والمدنية الحديثة (القاهرة: دار الأنصار، 1978)
[21]المودودي، منهج الانقلاب الإسلامي، مرجع سابق
[22] See Abu L-Ala Maududi, Islamic Law and Constitution (Lahore: Islamic Publications, 1969)
انظر أيضا: أبو الأعلى المودودي: تدوين الدستور الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1975)
[23] See: Daniel Pipes, In the Path of God: Islam and Political Power )New York: Basic Books, 1983). And
Detleve Khalid, “The Phenomenon of Re-Islamisation,” Aussenpolitik no,29 (1978): 433-533
[24] See: Esposito, Voices of Resurgent Islam (Oxford: Oxford University Press, 1983), p 11-14
[25] حيدر إبراهيم علي، "الأسس الاجتماعية للظاهرة الدينية: ملاحظات في علم اجتماع الدين"، في: عبد الباقي الهرماسي وآخرين، الدين في المجتمع العربي (بيروت: مركز درايات الوحدة العربية، 1990)، صص 33-36
Mark Tessler,The Origin of Popular Support for Islamic Movements, in John P. Entelis (ed.) Islam, Democracy and the State in North Africa (Bloomington. IN: Indiana University Press, 1997), p.92-126
[26] صلاح الدين الجورشي، "الحركة الإسلامية مستقبلها رهين التغييرات الجذرية"، في: عبدالله النفيسي (محرر) الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية، أوراق في النقد الذاتي (القاهرة: مكتبة مديولي، 1989)، صص 117-147
[27]Ernest Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals (London: Penguin Books, 1994)
[28] عزيز العظمة، العلمانية من منظورمختلف، (بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية، 1992)، ص221-248
[29] Dale F.Eickelman and James Piscatori, Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 28-36
انظر أيضا: عزيز العظمة، مرجع سابق، ص 312
*ضياء رشوان، مرجع سابق،صص19-23
[30]للمزيد من المعلومات في هذا الخصوص انظر:مجدي حماد (وآخرون): الحركات الإسلامية والديمقراطية: دراسة في الفكر والممارسة (مركز دراسات الوحدة العربية، 2001) صص248-386
*ضياء رشوان، مرجع سابق،صص23-24

 RSS Feed
RSS Feed